مثلت فترة الحجر الصحي، والفراغ الكبير الذي نتج عنها لدى طائفة غير يسيرة من الناس، فرصة لعودة النقاش حول عدد من القضايا، والتي تتخذ طابعا إشكاليا في مجتمعنا المغربي في الآونة الأخيرة. ويأتي في مقدمة هذه القضايا قضية العلم والدين والعلاقة بينهما. فمع أننا لا نستطيع أن نزعم أن لدينا “مجتمعاً علميا”، يضم أعضاءً تطبّعوا بالروح العلمية، وصاروا يصدُرون عنها في مواقفهم وآرائهم، إلا أننا نلاحظ أن ثمة أشخاصا أو تيارا، وإن كان اعتبارهم تيارا قائم الذات فيه تجوُّز، يحاولون توظيف بعض المخرجات – “Outputs” العلمية في معركتهم ضد تيارات أخرى، وذلك لتحقيق أغراض غير علمية، وإنما هي أغراض وتصفية حسابات أيديولوجية في الدرجة الأولى. ويتم لهم ذلك عبر “استصنام العلم” أولا، ثم اختلاق تقابل بينه وبين الدين، ومن ثم جعله الحاكم والفيصل على كل ما عداه ثالثا. فهل الروح العلمية نفسها تقبل بهذا الاستصنام؟ أم أن العلم أقل تبجحا، وأكثر تواضعا من أن يدعي لنفسه هذه “الحاكمية”؟
إذا كنا قد تعلمنا شيئا في الأسابيع القليلة الماضية، فهو تأكُّد حاجتنا إلى تطوير حسنا النقدي في التعامل مع مصادر المعلومات، ومع تلك المعلومات ذاتها. إن هذه الحاجة وإن كانت ليست وليدة اليوم، إلا أنها قد أصبحت أكثر إلحاحاً، بعد المتغيرات والتطورات الهائلة التي تعرفها حياتنا على هذا الكوكب. فلا يمكن أن نثق ثقة عمياء في أي شخص أو أي مصدر، علميا كان أو غير علمي، بل لا بد أن تخضع كل مصادر معلوماتنا للمساءلة والفحص والنقد، لأن ذلك وحده هو ما يَمنعنا من الوقوع ضحية المغالطات والأخطاء والمعلومات المضللة، باسم العلم تارة، وباسم الدين تارة أخرى، وربما بأسماء أخرى كالوطنية والهوية وغيرها.
ويبدو في بادئ الرأي أن الثقة العمياء في العلم قد تعرضت في الآونة الأخيرة إلى بعض التشكيك. فقد فاجأ فيروس كورونا، كوفيد ـ19، الجميع؛ ووجد المجتمع العلمي الدولي، -الطبي منه خاصة، ممثلا في منظمة الصحة العالمية- نفسه متخبطاً أمام هذا الفيروس المستجد، ما دفعه إلى اتخاذ عدة قرارات بدا في وقت لاحق أنها غير سديدة، اضطر إلى الاعتراف بكونه قد أخطأ فيها ثم التراجع عنها. كما أنه اضطر إلى الاعتراف بالجهل التام بهذا الفيروس في أول الأمر، كما اعترف أن اختراع لقاح له قد يأخذ سنوات. وهذا كله قد أصاب كبرياء العلم ببعض الحرج. وصرنا أمام لغة علمية مغرقة في التواضع، تتحدث عن “إمكان” إيجاد لقاح لهذا الوباء، وهو ما يعني اعترافا علميا بأن احتمال العجز عن إيجاد هذا اللقاح المنشود هو احتمال قائم بشدة.
إن الوضع الطبيعي أن يستند الناس في تشكيل رؤاهم ومواقفهم إزاء هذا الفيروس أو غيره إلى المعطيات العلمية المعترف بها، وذلك يتم أساسا بالاستشهاد بسلطة علمية لتعزيز هذا الرأي أو ذاك، سواء أكانت هذه السلطة مجلة علمية مرموقة أم منظمة دولية، بما في ذلك منظمة الصحة العالمية، أو رأي طبيب متخصص مشهود له بالكفاءة العلمية. لكن الناس فوجئوا بأن “الفتاوى” العلمية إزاء هذا الفيروس كانت متغيرة ومتضاربة، وظلت المعطيات العملية المقدمة بخصوصه محل شكوك معقولة. وغني عن البيان أن هذه الشكوك لا ينبغي أن تَحملنا على رفض العلم، أو اتخاذ موقف سلبي منه، أو التفكير في إمكان آخر غير علمي يمكننا أن نواجه به هذا الفيروس.
لكن هذا الوضع ينبغي أن يحملنا على تصحيح منظورنا للعلم، إذا كان خاطئا. فطبيعة العلم أنه يتطور ويتغير، وأنه يخطئ أحيانا، وأنه قد يعجز في أحيان أخرى. فليس مفاجئا لمن درسوا دراسة علمية هذا التذبذب الذي حصل في الآونة في معطيات افترض فيها في الأول أنها معطيات علمية دقيقة، لأننا ببساطة أمام فيروس مستجد، والمعطيات العلمية حوله أولية، ولم يتمكّن المجتمع العلمي بعدُ من التعرف عليه بشكل دقيق وكامل، فضلا عن التعرف على طرق علاجه والوقاية منه. وهذا ليس جديدا على المجتمع العلمي، فالسيدا على سبيل المثال تم اكتشاف الحالات الأولى منها في سنة 1981، وتم التعرف على الفيروس المسؤول عنها في سنة 1984، قبل أن يتم اقتراح الأدوية في سنة 1995، ولم يعمم الدواء على نصف المصابين – فقط- إلا بحلول سنة 2017.
وقبل أن نواصل الحديث، نجد أنه من المفيد في هذا السياق، أن نلخص ما حدث خلال الأسبوع الماضي حتى يكون القارئ غير المتتبع لما جرى على اطلاع بما نتحدث عنه. وملخص الموضوع أن منظمة الصحة العالمية وعدداً من الحكومات الوطنية غيّرت سياساتها وطرق تعاملها مع مرض كوفيد-19، استنادا إلى بيانات معيبة ومشكوك في صحتها، مقدمة من شركة سورجيسفير الأمريكية، التي تقدم نفسها على أنها شركة تحليل للبيانات الصحية، ونُشرت في مجلة «دي لانسيت» العلمية المرموقة. غير أنه قد تبين بعد تحرّيات معمقة بأن هذه البيانات جاءت من العدم، وأن الشركة المذكورة لا تضم إلا إحدى عشر موظفاً، مشكوك في قدراتهم العلمية، إما لكون خلفيتهم العلمية بسيطة للغاية، أو لكونهم في الأصل لا يتوفرون على أية خلفية علمية. قبل أن يتبين أن هؤلاء لم يلتحقوا بالشركة إلا قبيل أشهر قليلة، ووُجد من بينهم موظفة مدرجةٌ بوصفها محررة علمية، هي في الأصل ليست إلا كاتبة قصص الخيال العلمي، كما وُجدت موظفة أخرى مدرجة بوصفها مسؤولة تسويق، وهي عارضة إباحية ومضيفة حفلات!
وبعد أن أثيرت الكثير من الشكوك حول الطريقة التي حللت بها تلك الشركة الهاوية البيانات المتعلقة باستعمال عقاقير “الهيدروكسي-كلوروكين” لعلاج جائحة القرن، قامت المجلة المذكورة بالتراجع رسمياً عن الدراسة التي تم نشرها في 22 ماي، حول مضاعفات استعمال عقار الهيدروكسيكلوروكين في البروتوكول العلاجى لمرضى كوفيد-19.

كما تراجعت لأسباب مختلفة، وبشكل رسمي أيضاً، المجلة العلمية المرموقة”NEJM” عن دراسة بخصوص تأثير استعمال دواءين لعلاج أمراض القلب على المرضى المصابين بالكوفيد-19.
وهذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها سحب مقال علمي، بعد أن ثبت فيه غش أو خداع أو تلاعب في المعطيات، بل هذا تقليد علمي مستمر، تلجأ إليه المجلات العلمية المحترمة عند وجود سبب لذلك. ومن أشهر المقالات التي تم سحبها، المقال الذي نشر في 1998 والذي يربط بين التلقيح والتوحد عند الأطفال، على نفس المجلة.
وينبغي أن يعلم القارئ الكريم أننا حين نتحدث عن مجلتي The Lancet وNEJM فنحن نتحدث عن أهم مصدرين علمين موثوقين في العالم الطبي، إلى درجة أن بعض من يُقدّسون العلم عندنا قد يعتبرونهما بمثابة “الصحيحين”؛ إذ يتلقون بالقبول والاستسلام كلَّ مقال علمي ينشر فيهما، بدعوى أنه يخضع إلى منهجية علمية صارمة، يستحيل معها ورود أي خطأ فيه، ويدافعون عن كل ما يُنشر فيهما بطريقة قد نشعر معها أن هؤلاء يتحدثون عن معصوم لا يخطئ، ولا يمكن أن يتحيز ولا يدلس أو يتهاون في التحقق أحيانا.
في الواقع، إن المطلع على حقيقة العلم يَصعُب أن يسير في منحى استصنامه أو تأليهه، فما يزال بعيداً عن أن يجد حلا لكل مشكلة، أو تفسيرا لكل ظاهرة. إذن من بين أكبر الشاهدين على هذه الحقيقة هم الأطباء الذين يعايشون تطور العلم بشكل دائم؛ إذ في كل سنة تتغير بروتوكولات علاجية، ويتغير معها تشخيص الأمراض، وتفنذ نظريات علمية قائمة لمدة طويلة، لتقوم نظريات جديدة مختلفة عن سابقاتها، مع بقاء الكثير من الحقائق الطبية مجهولة. ولا شك أن كل من درس الطب يكون قد قرأ مصطلح “Idiopathic” الذي يعني أن السبب مجهول مراراً وتكرارا. وينضاف إلى ذلك الأرق العلمي المتعلق بالأسباب المباشرة لغالب السرطانات -وأعني بذلك الأسباب المباشرة لوقوع الطفرات وليست الطفرات ذاتها- والأمراض التنكسية كذلك، والتي لا تزال أسباب العديد منها مجهولة، رغم شيوع هذه الأمراض وانتشارها وقدمها.
ولا زلنا نكتفي برد الكثير من أسبابها إلى فرضية أنها وراثية، وهو نوعٌ من التخلص من الاعتراف بالعجز عن معرفة السبب الحقيقي، في الغالب. كالعجز الثابت حول معرفة سبب وتعافي مرضى بشكل كامل دون آخرين، مع أنهم يعانون من المرض نفسه، وبنفس الأعراض والحدة.
العلم إذن أكثر تواضعاً مما يُقدَّم عليه، وهو يتطور بشكل مستمر، دون أن يعني هذا أنه قد يصل يوماً إلى معرفة كل ألغاز الكون؛ فهذا مطمح بعيد المنال. وألغاز الكون أكبر بكثير من أن يحاط بها بشكل كامل. فلو أخذنا على سبيل المثال تنزلا وافتراضا، قضية الانفجار العظيم، فسبب حدوثه لا يزال مجهولا: لماذا في تلك اللحظة بالضبط، أعني قبل 13.8 مليار سنة؟ لماذا لم يحدث هذا الانفجار قبل ذلك؟ وماذا كان قبل الانفجار العظيم؟ وكيف ظهرت وتشكلت أول خلية على وجه الأرض بالتفصيل؟ وماذا وقع في دماغ الإنسان الأول؟ إذا ما تتبعنا التسلسل التطوري للأجناس لكي يصبح أكثر ذكاءً وتواصلاً وتنظيماً وتعبيراً عن نفسه بكل أنواع الفنون دون سائر المخلوقات!؟
إنه على افتراض التسليم في هذه القضايا، فليست هناك إجابة واضحة عن هذه الأسئلة المتعلقة بها. نعم، العلم يحاول أن يُفسر نواميس الكون، و”كيف” تتفاعل الأشياء في الطبيعة، لكن مع ترك الكثير من الفراغات المعرفية المؤثرة، والتي تحتاج إلى ملءٍ وإجابات. نعم، العلم يحاول جاهداً أن يفسر “كيف” تشكلت الحياة، وكيف ظهرت الأمراض وما أسبابها، وكيف يمكننا علاجها. لكن كل ذلك في نطاق الجهد الإنساني. وفي الحقيقة، فنحن حين نقول: إن العلم يحاول، إنما نقصد أن الإنسان يحاول عن طريق العلم، لأن هذا العلم لا قيام له من دون الإنسان. ومن ثم يكون العلم محدوداً، لتوقفه على علة محدودة، وهو الإنسان: الكائن الضعيف. بالإضافة إلى أن اللغز الذي يحاول الإنسان حله هو في الأصل جزء منه.
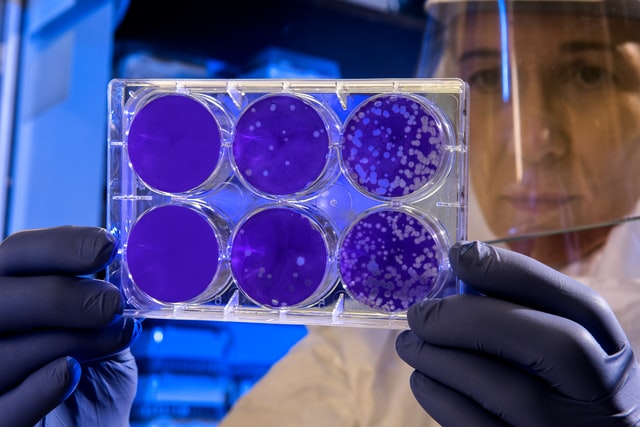
وبعد،
فهل معنى ما قلناه أن العلم شيء لا قيمةَ له؟ وأننا ينبغي أن نهجره لقصوره قصورَ الإنسان؟ أو علينا أن ننتقصه ونشكك في أصله وجوهره؟ أو أن نحارب هذه المجلات ونطرحها ونهجرها؟ من البين أن الجواب بالنفي. لا يستقيم هذا التصرف، ولا يصدر من إنسان رشيد. فنحن مدينون للعلم وللجهود العلمية في تحسن حياتنا، بل ينبغي أن يكون لنا موقع مشهود وصوت مسموع وإنتاج مذكور في هذه العلوم. فالاعتراف بقصور العلم إنما يلزم منه أن لا نسعى إلى تأليهه، لا الوقوع في إنكاره وإنكار الحاجة إليه. وحين نُدرك الأمور على هذه الشاكلة، سندرك أن تلك المعارك التي تُخاض في مجتمعنا في الآونة الأخيرة لا تقوم على أساس من الفهم السليم للعلم وللدين معا.
إن الأخطاء العلمية للمجلتين المذكورتين المتعلقة بالبحوث حول كوفيد 19 حاول بعض الناس استغلالها بشكل غير علمي لتحقيق انتصارات أيديولوجية وهمية، بالتنقيص من العلم والميل إلى استصغار شأنه. والحق أن العلم لا يُزعزَع مقامه ومكانته، ولا يؤثر في كون الحاجة إليه ماسةً خطأ علمي هنا أو هناك؛ لأن الوقوع في الأخطاء في العلم أمر لازم، وبها يتطور، حتى قيل: تاريخ العلم إنما هو تاريخ أخطاء العلم. وهذا التصرف شبيه بصنيع بعض “العلمويين” الذين يتشبثون بأخطاء بعض الشيوخ فيحاولون الإساءة إلى الدين كله من خلالها. والحق أن الفريقين وإن كانا مناقضين لبعضهما البعض فشأنهما واحد. فلا خطأ عالم يهدم صرح العلم، ولا خطأ شيخ أو داعية يهدم صرح الدين. وكما يخطئ العالم يخطئ الشيخ والداعية، والخطأ من لوازم الإنسان، ولو رُفع عنه الخطأ لما بقي إنسانا.
إن ما يفتقر إليه الطرفان هو الحس النقدي السليم، فالعلموي الذي صنّف الدينَ عدوَّه -وحين تصنف شخصا- شيئا عدوا استحال عليك فهمه، على حد تعبير نيتشه- فيسعى للنيل منه بتأليه العلم، وإعطائه مكانة ورفعة وأرجحية في تفسير كل مناحي الحياة، مع تجاهل كل ما عداه من علوم إنسانية أخرى، فضلا عن الرؤى الدينية المنزلة. فكل ما لا يخضع للمنهج التجربيبي ولا يمكن التحقق منه تجريبيا هو فكر خرافي أسطوري يجب أن يهمل ويُهجَر. وكل كلام لا يمر عبر المجلات العلمية كـــ “نايتر” و “ذي لانسيت” و “نيجم” وغيرها من المصادر العلمية فلا ينبغي أن يُلتفت إليه. فهذه الصحف وحدها الصحف المكرمة، والتي لا يمسها إلا المتشبعون بالروح العلمية “المزعومة”، والمتطهرون من كل الرؤى الأسطورية وخرافات العصور الوسطى، عصور الظلمات والجهل!
وأما المتشددون الدينيون فافتقارهم إلى الحس النقدي أظهر، ولعلنا تحدثنا عنهم بشكل مفصل في مقالات سابقة. لكن يكفي أن نشير هنا إلى أن الشخص الذي يتمتع بحس نقدي نشيط وسليم لا يمكنه أن يعتنق أفكارا متطرفةً، تجعل من الدين سببا في إفقاد الناس حياتهم، أو في التنقيص من قيمة العلم التجريبي الذي قد ثبتت فائدته في حياة الناس ثبوتا يقينا. الشخص الذي تكوّن لديه تفكير نقدي بسيط لا يمكن أن ينطلي عليه أن التطرف المتنكر في لبوس الدين هو أقبح القبائح، وأن الإساءة فيه مزدوجة؛ إساءة إلى ذات الإنسان من حيث هو إنسان، وإساءة إلى الدين نفسه، بإجازة نسبة ذلك التطرف إليه، وتسويغ نتائجه الكارثية انطلاقا منه، بتأويلات سخيفة متكلفة، لا يقبلها روح الدين نفسه، الذي عرّف نفسه بأنه “الرحمة للعالمين”، وعرف نبيه نفسه بأنه “الرحمة المهداة”، فكيف تجتمع الفكرتان في عقل واحد؟! كيف يمكن أن يعارض الدين الذي جاء لمصلحة الإنسان العلم الذي فيه وبه تحفظ مصالح كثيرة للإنسان؟
إن الفريقين معا، وإن كانا على طرفي نقيض، فإن ما ينتهيان إليه واحد؛ وهو إقامة تعارض موهوم بين الدين والعلم. والفرق بينهما يكمن فقط في كون أحدهما يغلب العلم على الدين، والآخر يغلب الدين على العلم. ومن المُسَلّم أن الدين غير العلم، لكن غير مُسَلّم أن “غير” هنا تعني “مناقض” أو “ضد” أو “منافي” أو غيرها من المصطلحات التي تؤدي نفس المعنى. فجوهر الدين مختلف حقا عن جوهر العلم، لكن التباين في الجوهر لا يعني التنافي في الغاية والفائدة. فالدين في جوهره قائم على الاستسلام للأوامر الإلهية، التي هي كلها في مصلحة للإنسان، في حين أن العلم قائم على البحث والتجربة، ويخضع للتغير والتبدل باستمرار. ولا يلزم من هذا بأي شكل من أشكال التلازم أن أحدهما يجب أن يلغي الآخر؛ لأن الجميع في خدمة مصالح الإنسان الروحية والمادية.
إن معركة التعصب، تحت أية راية كانت: الدين أو العلم، هي معركة خاسرة. لا تدل إلا على الفقر الفكري والجمود العقلي والجفاف الروحي. وهذه الآفات ما اجتمعت في إنسان إلا أهلكته وأهلكت من اتصل به اتصالا قريبا أو بعيدا؛ فهي آفة يتعدى خطرها إلى الغير. ومن أجله لزم التصدي لها بكل الوسائل العلمية والتربوية والقانونية اللازمة. فالروح العلمية لا تبرر الاستهزاء بمقدسات الآخرين أو الاستهزاء بشكل المرء أو لحيته أو لباسه.
بل إن العلم في الحقيقة لا يستطيع أن يخبرنا بأي شيء عندما نبتعد عن العالم المادي، الشيء الذي يبرز الحاجة إلى الدين وتكامله معه، غير أن هذا لا ينقص من مكانته كما سبقت الإشارة إلى ذلك.
والتدين لا يقوم مسوغا لتحقير أحد أو تكفيره، أو التنقيص منه أو محاولة النيل منه ماديا أو معنويا.

إن الإنسان الكامل هو الذي لا تغره الابتكارات العلمية، ولا تقوم حجابا له عن إدراك ضعف الإنسان وحاجته إلى يقين وإيمان، إذ حاجاته أوسع من أن تختزل في الحاجات المادية؛ ولا يغره كذلك إيمانه بالله، فيطلق لنفسه عنان الحكم على الآخرين وتحديد مصائرهم. الإنسان السوي هو من يدرك أن طرق المعرفة بالله تتعدد، وأن العلم قد يكون أحد أهم هذه الطرق، وأن الدين كان ولم يزل عنصرا هاما في تاريخ البشرية، وكم مرة كان هو العزاء الذي جعل الإنسان يقاوم ويستمر على هذه البسطة. والناس بديهي أنهم ليسوا سواء، ولذلك فالحاجة إلى التوازن الفكري والتنوع المعرفي من أهم ما يُثري الوجود الإنساني. فلو كان كل الناس علماء لهلكوا، وكذلك لو كانوا جميعا فلاسفة أو علماء دين أو غير ذلك؛ فالتنوع حتمية وجودية إنسانية.
إن المعركة التي ينبغي أن نشمر لها سواعدنا هي المعركة التي نتأكد أنها معركتنا، وإني لموقن أن معركة الدين والعلم، إذا وجدت، فهي قطعا ليست معركتنا؛ إذ لطالما كان العلم والدين جنبا إلى جنب في تاريخنا البشري، إذ الثورة العلمية التي عرفتها الحضارة الإسلامية على سبيل المثال كان أحد محركاتها الرئيسية هي الروح الدينية التي تبتغي مرضاة الله من وراء ذلك العمل؛ ولطالما دعى هذا الدين على وجه الخصوص إلى التفكير والتعقل والبحث، ونوه بالعلماء ورفع من مقامهم، ترغيبا في العلم. وعليه، فإذا وجدنا من بني جلدتنا من يحاول النفخ في رماد هذه المعركة علينا أن ننبهه إلى أنه يقوم بإسقاط فج، لا يستسيغه ذو لب. ولو أنه أوتي من العقل والنظر حظا يسيرا لأدرك أن ما يقوم به هو الخبل عينه. ونعوذ أن تكون مصيبتنا في عقولنا، فإنما تميز الإنسان بعقله.
وبقي أخيرا أن نشير إلى أن السخرية والاستهزاء سلاح الجبناء الواهمين. وأن العلم الحقيقي لا يمكن أن يكون إلا متجردا، لا يخدم أيديولوجية معينة. وكل محاولات توظيف العلم لغير الأغراض العلمية تنتهي إلى الفشل. والانتقاء مرض خبيث، لا يمُس إنساناً إلا كشف عن رسوخ جهله. فالعلم ما كان في خدمة الإنسان، لا في خدمة الأيديولوجيا. والدين الحق ما فيه هداية الإنسان واطمئنانه، وليس من مقاصده أن يُثبت حقيقة علمية هي محل بحث وتجربة إنسانية متغيرة.


