آراؤنا بين مطلق الحرية وأسر التبعية: قراءة في كتاب الآراء والمعتقدات لغوستاف لوبون
يفصل كتاب الآراء والمعتقدات لغوستاف لوبون (Gustave Le Bon: 1841/ 1931) أسباب تبني الناس لمواقف معينة وإعراض آخرين عنها؛ إذ يرجع الأمر في نهاية المطاف إلى أساليب تبني هذه المواقف، والتي قد تكون عاطفية أو عقلية، وبواعث تبني ذات المواقف سواء لتحقيق الرضا الذاتي بحرية الاختيار عند الفرد الحر، أو الشعور بعظمة الانتماء عند الفرد داخل زمرة الجموع. ويُعنى الكتاب بمجموع العوامل والأسباب المؤثرة في تبني الآراء والمعتقدات سواء تعلق الأمر بالمرء كفرد، أو كجزء من جماعة، مبرزا الدور الفعال والمؤثر الذي يقوم به عمل المشاعر والأحاسيس مقابل عمل العقل المنطقي، باعتبار النهج الأول طريقا للوصول إلى التبني الخالص للمواقف الفكرية والاجتماعية دون تحليل أو تمحيص، ثم النهج الثاني الذي لا يخلو موقف فيه من اختبار وتجربة ومشاهدة، بشكل يجعل أساليب دحضه ممتنعة، إلا إذا قوبل بأساليب من نفس النهج.
وقد جعل لهذه الدراسة الدقيقة تسعة أبواب، خصص الفصول الأولى منها لتفصيل الحديث في المفاهيم المرتبطة ارتباطا وثيقا بالعوامل المؤثرة في تبني الآراء، كالمعتقد، والمعرفة، والحس والذات والمنطق، أما الفصول الأخرى فقد خصصها للحديث عن العوامل الباطنية والخارجية لتكوين الآراء والمعتقدات عند الأفراد، ومدى ارتباط هذه العوامل بتكوين آراء الجموع وتأثيرها ومدى فناء روح الفرد فيها.
ميز في الباب الأول، والذي عنونه بالمعتقد والمعرفة؛ بين هذين المفهومين مع أنهما أمران نفسيان، معتبرا أن المعتقد “كناية عن إلهام لاشعوري ناشئ عن علل بعيدة من إرادتنا، والمعرفة عبارة عن اقتباس شعوري عقلي قائم على الاختبار والتأمل.”
وخصص الباب الثاني للحديث عن ميدان الآراء والمعتقدات النفسي، معتبرا أن اللذة، والألم، والحس والمشاعر بمثابة عواطف تؤثر في تبني الآراء والمعتقدات؛ لأن الحس يقوم بدور فعال في خلق تموجات وتقلبات في أفكارنا وآرائنا على مر العصور؛ ذاك أنه شعور غير لازم حالا وامتدادا في الحفاظ على نفس الرؤى، وقد يصل إلى الكشف حتى عن المثل العليا كالحب والسعادة والأمل من جهة، والمعتقدات من جهة أخرى بهدف الكشف عن مدى صحتها أو بطلانها.
ثم انتقل بعد ذلك للحديث عن المشاعر؛ كونها لا تنفذ دائرة الشعور إلا بعد أن تنضج في منطقة اللاشعور، ومثال هذا، تلكم التراكمات التي ورثناها عن المدرسة الأبوية والمدرسة المجتمعية من عادات وتقاليد…فسرعان ما يجد المرء نفسه يرددها أو يعمل بها دون تمحيص أو كشف، فقط لأنها استقرت في الأصل في ذهنه دون وعي منه، وهذا التراكم هو ما يفسر -كذلك- جهلنا بمشاعرنا الحقيقية نحو ما يحيط بنا إلى حين تفجيرها عن طريق بعض المحرضات الخارجية كالحزن أو السعادة…وبعد التحقق الفعلي لنتائج هذه المحرضات نقول: “لم أتوقع أنني كنت سأتعامل مع الوضع هكذا”
يستفاد من هذا، أن المشاعر تبقى كامنة في اللاشعور، ولا يمكن محوها أو زجرها؛ لأنها من صميم أحاسيسنا، لكن من الممكن تغيرها وتبدلها بحسب الأحوال النفسية، وهو ما عبر عنه بتغير اسم المشاعر، لكن طبيعة المشاعر في حد ذاتها لا تتغير.
أما العواطف الدينية، فقد اعتبر لوبون أنها لا تخضع للقوانين العقلية، بل هي مزيج من الأحاسيس الكامنة في اللاشعور كذلك، والتي تدفع المرء إلى الإيمان بقوى عليا غيبية وخشيتها…والتي قد تؤدي في كثير من الأحيان إلى فعل ما ينافي العقل صراحة؛ كالمعتقدات الناجمة عن تعاليم الديانات غير السماوية، لهذا لا يمكن السيطرة عليها؛ لأنها لا تخضع لقوانين منطقية مما يجعل من نسفها أمرا غير قابل للتحقق، إلا إذا تم تحليل معانيها منطقيا.
أما الباب الثالث الموسوم بأنواع المنطق المسيرة لآرائنا ومعتقداتنا، فقد تحدث فيه عن كل نوع من هذه الأنواع؛ وهي: منطق الحياة، والمنطق العاطفي، ومنطق الجموع، والمنطق الديني والمنطق العقلي.
وقد استهل الحديث بمنطق الحياة مُعَرِّفا إيَّاه بأنه: “يسيطر على بقاء الأنواع وأشكالها، يجري حكمه بعيدا من تأثير إرادتنا، ويأتي بمطابقات تسير بفعل قوى لا نعرف من أمرها شيئا.”
في حين ميز بين المنطقين العاطفي والعقلي نظرا لاستقلال كيان كل واحد منهما، ممثلا لهذا التمييز بمجموعة من المقاييس، من ذلك: أن المنطق العقلي يدير دائرة الشعور، وأما المنطق العاطفي فهو مستولٍ على دائرة اللاشعور، ويستند المنطق العقلي إلى مبادئ مادية مستنبطة من التجربة والاختبار، في حين لا دعامة للمنطق العاطفي سوى مبادئ معنوية أدبية يتعذر قياسها وتقديرها على وجه الضبط والصحة، بالإضافة إلى أن أفكار المنطق العقلي تشترك حسب قواعد عامة معلومة، في حين أن مشاعر المنطق العاطفي تجتمع على شكل غير إرادي.
أما منطق الجموع، فهو أس التأثر العاطفي المكون لآراء الناس ومعتقداتهم؛ حيث تنمحي الشخصية الفردانية للشخص، فيكون “وهو جزء من الجماعة في سيرِه غيرُه وهو منفرد، وهذا ما يجعلنا نقول: إنه مسير وهو في الجماعة بمنطق خاص يتضمن ما يشاهد في الجموع وحدها من أصول ومبادئ.”
أما النوع الخامس فهو المنطق الديني المنبعث من روح المرء الدينية، الذي يدفعه إلى خلق ارتباط بين الحوادث والأشياء ناسبا الأمر إلى موجودات علوية غيبية.
وقد خلص لوبون في الباب الرابع عند حديثه عن العراك بين أنواع المنطق إلى أن المنطق العقلي لا يقوى أمام المنطقين العاطفي والديني؛ وذلك لقوة المشاعر الخفية وسيطرتها على مختلف حياتنا، وهذا ما يبرر انتساب العديد من العلماء “العقليين” إلى ديانة ما؛ إذ لا يتبعون المنطق العقلي فيها، بل يجعلون المنطقين العاطفي والديني مبررا لانتسابهم لها.
ليس هذا وحسب، وإنما هذا النوع المسيطر من المنطق -العاطفي- لا ينهزم حتى أمام الجموع، كالحروب والثورات؛ إذ لا منطق يحكم تصرفات الشعوب وإنما المشاعر.
أما الباب الخامس الذي وسمه بآراء الأفراد ومعتقداتهم والذي تحدث فيه عن العوامل الباطنية والخارجية التي تتدخل في تبني الآراء والمعتقدات، وتتمثل في الخُلق باعتباره مؤثرا على المنحى الإيجابي في خلق أناس محافظين، وعلى المنحى السلبي في خلق ثوريين، والمَثَل الأعلى على اعتبار أنه “خلاصة رغائبها العامة واحتياجاتها وأمانيها، والناظم لهذه الخلاصة هو العرق” والاحتياجات التي يُعد الافتقار إليها أساس تكوين الرأي، ومثال ذلك الجوع الذي ساق الأوائل من الكهوف إلى سلم الحضارة، وذلك لموازاة تقدم الحضارة لتقدم الاحتياجات، والمنفعة التي تسعى بالمرء بقدرته إلى تحويل كل ما يلائمه إلى حقيقة، ثم الحرص “الذي يحرك نشاط الإنسان، ولكنه في الغالب يفسد الرأي، ويمنع الإنسان من أن يرى الأمور كما هي، وأن يفهم صورة تكونها.”
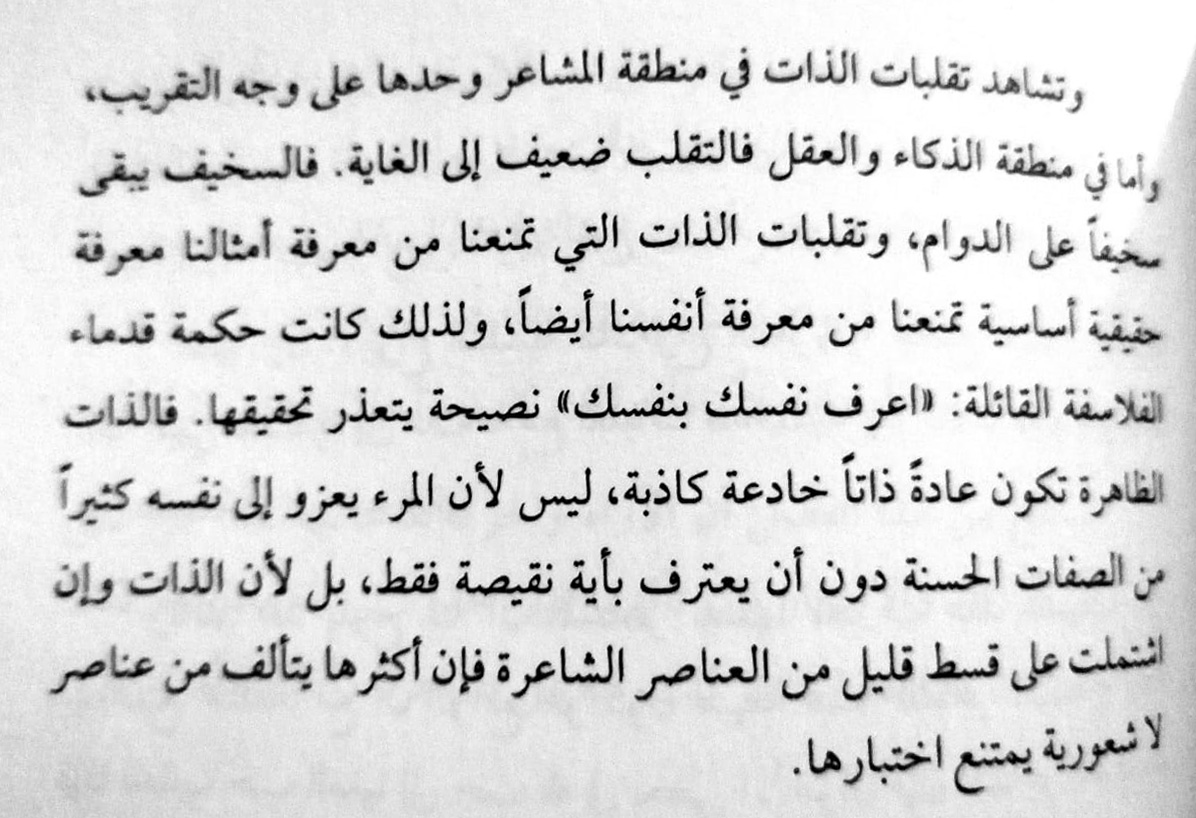
أما العوامل الخارجية للآراء والمعتقدات، فتتلخص في التلقين الذي هو ”كناية عن قوة الإقناع ليس بالأفكار وحدها، بل بعامل آخر؛ كالتوكيد والنفوذ…أما عن مناهجه فتشمل البيئة، والكتب، والجرائد، والخطب والعمل الشخصي.” والانطباعات الأولى التي تستقر في ذهن المرء، فيعتبرها دليلا يغير به آراءه واعتقاداته بسهولة، والاحتياج إلى التفسير فهو “كالاحتياج إلى الاعتقاد، يلازم الإنسان من المهد إلى اللحد، وقد ساعد على تكوين الآلهة، ويساعد على ظهور عدد غير قليل من الآراء، ويسهل قضاؤه، فأبسط الأجوبة تكفيه، وهذه السهولة هي مصدر كثير من الأغلاط.” والألفاظ والصيغ والصور لما لها من قدرة على إيقاظ مشاعر الحب أو الغضب في النفوس وشأنها في تكوين الآراء، والأوهام المفعمة بمشاعر الحب، والغضب، والفخر والشهرة…التي تدفعنا إلى المضي قُدما دون التفكير في مآل الأفعال ونتائجها، ثم الضرورة التي تمثل مجموع القوانين أو الأقدار التي تكره المرء على الخضوع لها.
تترسخ هذه العوامل الباطنية والخارجية في مواقفنا النفسية إذا تراكمت على مر السنين، خاصة إذا لم تجد عقلا ليمحصها وينقب فيها، حتى وإن كانت من ضمن العواطف التي يصعب تغييرها؛ لهذا نجد أن تأثير العقل قليل في الشعوب وفي حياتنا اليومية، ومما يدل على ذلك غلبة العاطفة عند صراعها مع العقل في أبسط تصرفاتنا اليومية المندرجة ضمن ازدواجية -اللذة والألم- وتبقى التجربة -مع قلة تأثيرها كذلك- المفر الوحيد المؤثر الذي يمكن الاستناد إليه للتحرر من هذه العلل المؤثرة.
انتقل لوبون في دراسته، للحديث بعمق عن آراء الجموع ومعتقداتهم مبينا أن الجماعات تنظم كثيرا من الآراء، ليس من محض استقلالها الفكري أو العقلي، وإنما تبعا للعرق الطويل الموروث، وكذلك البيئة التي يحاول الجموع التأقلم معها والإذعان إلى آرائها متى تغيرت، بالإضافة إلى الزمرة التي تضم الآراء والمعتقدات تحت سقف واحد، وهذا ما يكسب الجموع تأثيرا وقيمة، حتى وإن كان مخالفا لعمل العقل الحر؛ لأن القوة دائما ما تكمن في الجموع حتى وإن كانت مخالفة.
لهذا لم تستطع المجتمعات التخلص من روح الجموع، وذلك عائد بالأساس إلى ضعف الاستقلال الفكري والذاتي في الروح الواحدة، وهو ما أدى إلى الحفاظ على معظم الآراء والمعتقدات السائدة في المجتمعات الماضية أو الحاضرة، -ولم لا المستقبلية في حال بقيت روح الجموع ذات قوة كما هو الأمر الآن- ولا يمكن التخلص من هذا التأثير إلا بخلق ذوات متعددة حرة في التفكير لتحرر باقي الأفراد من التقليد إلى النقد، وبالتالي تأسيس منحى تطوري يعين الشعوب على قضاء حوائجها من دون الاستناد إلى آراء ماضية.
وقد بين لوبون أن حرية الفكر تضيق داخل الجماعة، ومن ثم تفنى روح الفرد داخلها؛ لأن الزمرة تحظر تفكير الفرد خارج مبادئها وآرائها، أما المساعي إلى تحرير الفرد من تأثير الجموع فيبقى حبيس الجهود التي يمكن أن نسعى بها إلى تحقيق ذلك، بدءاً بدراسة التاريخ على مر العصور، ليثبت أن عدد الأفراد الذين تخلصوا من هذه الربقة قليل، وتجدر الإشارة إلى أن الزمرة تبلغ أوج قوتها بفناء روح الفرد فيها، أما المجتمع فيبقى في أوج التخلف والتقهقر لعدم وجود ذوات فردية حرة قوية فيه.
تحدث لوبون في الباب السابع عن الأسباب المؤثرة في تبني وانتشار الآراء والمعتقدات، معتبرا أن أهمها تأثيرا:
- التوكيد والتكرار؛ باعتبارهما عاملان مؤثران فيهما، وعليهما يعتمد الزعماء في خطاباتهم سواء تعلق الأمر بالسياسة أو الدين، ويستند هذا الخطاب إلى الحماسة بشكل أساس في إحداث وقع في النفوس ليكون مؤثرا، أكثر من استناده إلى دليل عقلي ليعضده.
- المثال؛ وهو أكثر وجوه التأثير فعالية، ويعتبر ذكر مثال واحد مركز بارز أكثر تأثيرا من ذكر مئات الأمثلة الواهية.
- النفوذ؛ الذي يعتبر أساس الآراء والمعتقدات، وسبب ذلك هو سهولة تبني آراء العلماء أو المذاهب الأكثر انتشارا ونفوذا.
- العدوى النفسية؛ حيث يبلغ الخوف في النفس مبلغا يجعله يضحي بنفسه مقابل التحقق الفعلي لتبنيه لآراء ومعتقدات الجموع، وهو ما لا يجد العقل معه سبيلا لدحضه أو نسفها.
- الطراز؛ وقد بلغ مداه في تغير عناصر الحياة الاجتماعية، من ذلك مجموع الآراء الخاصة باللباس، والفنون، والعلوم، والسياسة والعلم كذلك، حيث بتنا –على إثره- نستحسن اليوم ما كنا نستبشعه بالأمس، أو العكس، أما عن بواعثه فإنه يُسيَّج بالعاطفة ويُسيّر بالعقل؛ إذ تجتاح الرأي عاطفة ما فيستحسنها العقل ويعين وجهتها.
- الجرائد؛ تقوم كذلك بدور خاص في التأثير يفوق دور الكتب؛ حيث تستغل الجرائد تصفح الناس الكبير لها في إطلاق الوعود دون الوفاء بها، وإطلاق أخبار دون الجزم بصحتها، وهو ما يساهم في تصديق الناس لها وتأثرهم بها أكثر من تأثر القراء بالكتب.
- الإعلانات؛ وتعتبر من أوجه التأثير الأكثر تأصلا في النفس؛ إذ يتم توكيدها وتكرارها تلفزيا وإذاعيا حتى تبلغ أوج تأثيرها.
تجتمع هذه الأسباب مشكلة جريانا للأفكار والآراء والمعتقدات محملا بالعاطفة ومبررا بها، ليثور الناس إيمانا بها ودفاعا عنها ثورانا خاليا من أي تبرير عقلي أو منطقي له.
انتقل لوبون بعد إيضاح عوامل وأسباب وأوجه التأثير في تبني آراء ومعتقدات الجموع والأفراد، إلى الحديث عن حياة المعتقدات مبينا مميزات المعتقد؛ حيث يتميز بصفات تحدد ماهيته، والمعتقد به، من ذلك أن المعتقد يجد مكانه في الحياة العاطفية للبشر، شأنه شأن الحاجيات الأخرى، مشكلا بذلك احتياجا نفسيا لا يتدخل العقل في دحضه أو تبريره أو تسييره، كما أنه لا تسامح في المعتقدات؛ حيث يخلق الناس فجوة بين المختلفين معهم دينيا، على اعتبار أن كل من اتبع معتقدا فقد أخذ الأصح مقابل معتقد غيره، وهو ما يتسبب في نشوب حروب وصراعات فكرية ووجودية بين ذوي المعتقدات المختلفة، وللرفع من شأن التسامح الاجتماعي، وجب على كل فرد التخلي عن التعصب والتطرف لآرائه ومعتقداته، وذلك بالابتعاد ومقاومة ما يتم تلقينه بشكل عام ومباشر دون تمحيص أو تفكر.
ويعود لوبون ليؤكد على أنه لا دخل للعقل في إثبات العقائد أو نفيها، ولو كان له السلطة المنطقية في هذا، لكان عدد العقائد في نقصان لا في تزايد؛ لأن العقل يكذب ما تقرره العقائد من أفكار ورؤى، وإنما يتدخل في ذلك العاطفة، وما استقر في لاوعي الناس من أعراف وتقاليد نتجت في اللاشعور.
لكن، يحدث أن تتدخل المعتقدات في أمر المعرفة من حيث نفوذها عن طريق البيئة أو الأستاذ، أو من حيث عدم توفر نظريات وفرضيات حولها، على اعتبار أن الاختبار والتجربة هما أس الحقائق، وهذا ما يجعلنا نستغرب من أقوال بعض العلماء بخصوص بعض المعتقدات مما لم يتخصصوا فيه، وكذلك الأوهام التي تستحوذ على النفوس إزاء الحوادث التي لا يتم التحقق منها.
إن خضوع المعتقدات لمبادئ عاطفية ودينية يجعلها في تقلب دائم، أما عن تطورها فيستلزم منا عدم الوقوف عند الرؤى التي أسست عليها، وإلا لم يُسمَّ هذا تطورا، ومما يدل على هذا التطور انقسام الديانة الواحدة إلى فرق ومذاهب، يسعى فيها كل عالم إلى فك ما التبس وغمض من نصوصها ورموزها. لهذا، يجدر بكل فرد منا تمحيص وتحليل واختبار كل موقف من المواقف التي تواجهه في أطوار حياته، كي لا يؤول أمره إلى التغيير السهل والسريع لمواقفه من حين لآخر، بالإضافة إلى خلق توازن حياتي يشعره بمدى أهليته للتعامل مع كل تغيير فكري أو اجتماعي دون تأثير داخلي أو خارجي على قراراته واختياراته.
وأختم بقول غوستاف لوبون حول نتائج تقلبات الحس المؤدية إلى تغير في المثل العليا والمعتقدات: “غاية الحركة في الإنسان هي البحث عن السعاة؛ أي طلب اللذة وطرد الألم…وللسعادة أشكال متنوعة مع اتفاق المقصود، فأحلام الحب، والغنى والرفعة، والإيمان، إن هي إلا أوهام مسيطرة تلقيها الطبيعة في قلوبنا لتسوقنا إلى أقصى الغايات، ومتى يتغير مبدأ السعادة، فإن طراز نظره في الحياة ومصيره يتغيران، وليس التاريخ سوى الإخبار عما يبذله الإنسان من الجهد في سبيل إقامة مثل أعلى، والقضاء عليه بعد أن يصل إليه ويكتشف بطلانه.”


