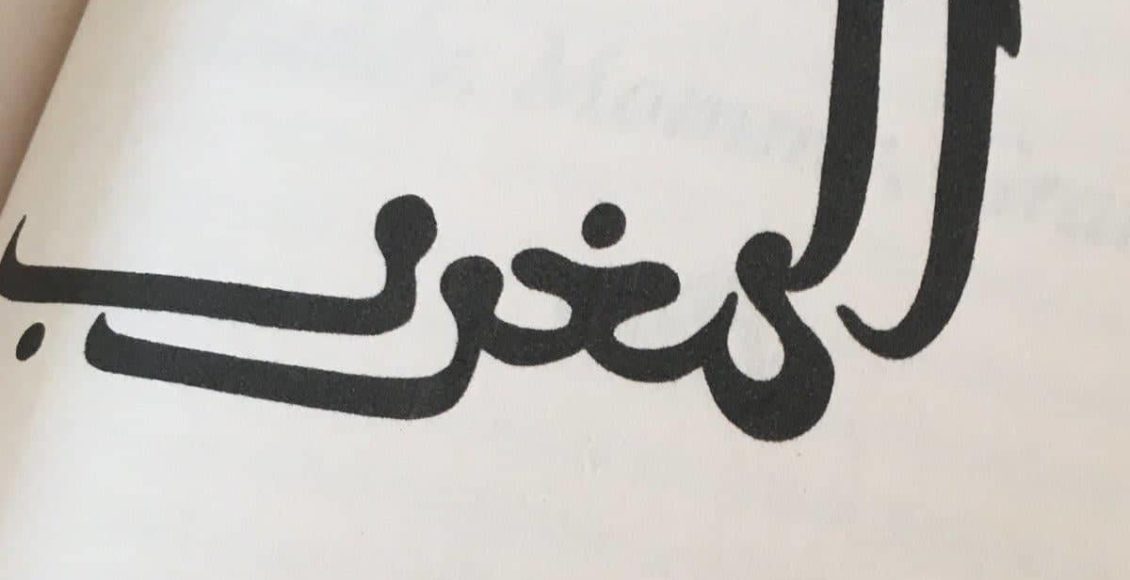يعيش المجتمع المغربي، كغيره من المجتمعات المغاربية التي كانت تحت وطأة الاستعمار الفرنسي، أزمةً من حيث الهوية اللغوية منذ الاستقلال إلى اليوم؛ حيث يعرف انقساما مستمرا بين نخبه ذات الولاء الفرنكفوني والنخب الأخرى الداعية إلى العودة إلى الهوية اللغوية والثقافية للأمة المغربية. وقد نجحت الفرنسية لغة وثقافة، لعقود من الزمن، في التغلغل داخل الإدارة المغربية وداخل الجسم الاقتصادي الوطني، حتى أصبح إزاحتها من هذه المجالات أمرا بالغ الصعوبة، وربما بالغ التكلفة أيضا. لكن الوعي المنتشر في السنوات الأخيرة بضرورة التخلص من هذا العبء من جهة، والعودة إلى اللغة الأم من جهة ثانية، والانفتاح على اللغة الإنجليزية، بوصفها لغة التواصل العالمي اليوم، ولغة العلم والاقتصاد، من جهة ثالثة، أجّج الصراع حول هذه المسألة مرة أخرى.
ومما زاد الطين بِلةً صدورُ القانون الإطار الخاص بتفعيل الرؤية الاستراتيجية 2030-2015، التي أعدها المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، والذي نص على أن من مبادئ النظام التربوي المغربي اعتماد التناوب اللغوي. هذا القانون الذي أعاد النقاش حول لغات التدريس بنظامنا التربوي، وأكد الأزمة التي أشرنا إليها سابقا.
لكن هذه النقاشات تثار منذ سنوات، خاصة عند حلول بعض المناسبات، ومنها اليوم العالمي للغة العربية الذي اختارت اليونيسكو أن يصادف الثامن عشر من دجنبر كل سنة، وهو تاريخ اعتماد اللغة العربية ضمن لغات العمل واللغات الرسمية داخل الأمم المتحدة سنة 1973، بعد اقتراح من المملكتين المغربية والسعودية. وغالبا ما يستغل المناصرون للعربية هذا التاريخ من أجل التذكير بأهمية النهضة اللغوية لنهضة الأمم بشكل عام، والدور الذي تقوم به اللغة القوية في النمو الاقتصادي والاجتماعي للدول، بالإضافة إلى بيان خصوصية هذه اللغة كونُها لغة القرآن الكريم، ووسيلتنا الأساس لفهم كتاب الله وسنة رسوله، وفهم كل التراث التي أَنتجته في ضوء هذين المصدرين من فقهٍ وتفسير وغيرهما، ومن حيث هي وسيلة أيضا لفهم التاريخ والحضارة الإسلامية، وهي من أجل ذلك تجد المناصرين لها والمدافعين ليسوا عرباً أصلا، وإنما هم مسلمون، ولولا ذلك ما دافعوا عنها ولا التفتوا إليها، إذ لن تعنيهم في شيء.
غير أن الذي نلاحظه حول هذه الأنشطة أنها دوما تنحو منحى مناقبيا “شعاراتيا”، كبيان عبقرية اللغة العربية وجماليتها وشاعريتها واتساع قاموس مصطلحاتها، ودقة ألفاظها وغيرها، دون أن تتجه هذه الأنشطة إلى البحث في كيفية النهوض بهذه اللغة من الناحية العملية المحضة.
وانطلاقا من تجربتي الشخصية، كوني درَستُ في المدارس الفرنسية، ودرست لاحقا في كلية الطب باللغة الفرنسية، حيث تعتبر الفرنسية الشرط الأساس في كفاءتك، وتسمو درجتك بقدر سموك في النطق بهذه اللغة، ويا ويحك إن ارتكبت خطأ فيها وأنت تقدم عرضا، سوف تغدو موضوع حديث الجميع. كما أنني بدأت التدوين باللغة الفرنسية، وكوني ريفيا في الأصل، لا عربيا. إذن من هذه التجربة سأتحدث في هذا المقال عن علاقتي بهذه اللغة، وكيف يمكننا الإسهام في الارتقاء بمكانتها في مجتمعنا المغربي.

في الواقع، يصعبُ على شخص عاش في مثل ظروفي أن يقتنع يوماً بأهمية العودة إلى اللغة الأم، ومحاولة إتقانها ما أمكن، بعد أن يكون قد تقدم خطوات متقدمة في اللغة الفرنسية، ومارسها تواصلا وكتابة وثقافة لمدة غير يسيرة، وخاصة أن الدراسة في المدارس الكاثوليكية الفرنسية تُرسخ لديك أن الفرنسية هي كل شيء، مفتاح كل نجاح، بل وتجد بعض الرسائل الضمنية غير المباشرة في بعض الدروس تومئ إلى أن اللغة العربية لا تعدو أن تكون لغة تاريخ تم تجاوزه، ولغة شعر –الجاهلي منه خاصة- لم يعد أحد يفهمه، بينما اللغة الفرنسية واللغة الإنجليزية هما لغتا العلم والحضارة والتقدم. وهذا يترسخ لدى الناشئة منذ نعومة أظفارهم. وهذه الرسائل غير المباشرة هي التي يتم تمريرها بشكل مباشر إلى المجتمع في مراحل لاحقة من طرف هذه النخب التي تتخرج من هذه المدارس.
وهذه الفكرة لا يتم ترسيخها بالمقررات والمناهج الدراسية فقط، بل يتم اعتماد وسائل أكثر تأثيرا وانتشارا كالأفلام السينمائية، حيث إنك لن تشاهد فيلما ملهما على الإعلام الرسمي إلا وتجده بالفرنسية أو الإنجليزية، كما أن بعض البرامج- على قلتها- التي تتناول قضايا علمية كلها باللغة الفرنسية. وعلى الجملة لن تجد في الإعلام شيئا فيه لمسة إبداع، ويستحق المشاهدة إلا وتجده بالفرنسية. فينشأ لديك، من دون وعي، اعتقاد مفاده أن الإتقان والإبداع والابتكار والاجتهاد والتميز والأصالة لصيقةٌ بهذه اللغة، وعكسُ هذه القيم مرتبطة بالعربية: لغة وثقافة وحضارة، وأن هذه اللغة لا تفيد في شيء، إلا ما يكون من تجييش العواطف وإلقاء الخطب العقيمة التي لا أثر لها في الواقع، ثم صار استعمال هذه اللغة، بتأثير من بعض الأفلام السينمائية، يرتبط فقط بالمواقف الساخرة، لا أكثر.
هل معنى ما سبق أننا يجب أن نكف عن تعلم اللغات الأجنبية بما فيها الفرنسية، الجواب بالنفي طبعا، يجب أن نتقن ما نستطيع من اللغات الأجنبية. بل أكثر من ذلك، إن الدفاع عن العربية والنضال من أجل إحلالها محلَّها الذي تستحقه في التدريس والإدارة والإعلام، من دون إتقان بعض اللغات الأجنبية، يمكن أن يكون محل تهمة وتشكيك، فما دام الشخص لا يتقن إلا لغة واحدة هي العربية فطبيعي أن يتعصب لها، ولكن حين تتقن اللغة الفرنسية كما يتقنها أهلها، ثم تدافع عن العربية يكون دفاعك عنها أقوى دلالة وأثرا من الذي يدافع عنها وهو لا يحسن غيرها، وإن كان ينازع في العربية، نحوا وصرفا وبلاغة، سيبويه أو ابن جني أو الجاحظ. وماذا يعرف عن بريطانيا، مَن يعرف كل شيء عن بريطانيا، ولا يعرف غيرها؟ يتساءل ظرفاء الإنجليز؛ والجواب أنه لا يعرف عنها شيئا، لأن الإنسان يكتسب المعارف بالمقارنة والمفاضلة بين الأشياء المتنوعة والمختلفة. والدفاع عن العربية يحتاج إلى أناس ناجحين على المستوى والشخصي، ومؤثرين اجتماعيا، وأعني أن الدفاع عن العربية لا ينبغي أن يتحول إلى مهنة يُرتزق بها.
ومن الإيجابيات هنا، أنه في السنوات الأخيرة، صار الناس يقرؤون بالعربية أكثر، ذلك أن بعض دول الخليج صارت أكثر نشاطا في ترجمة الكتب والروايات العالمية وإتاحتها للقارئ العربي بلغته الأم، والدور الذي قامت به الكويت في هذا الباب لا بد أن يُذكر ويُشكر، بالإضافة إلى دول أخرى. ذلك أننا في العالم العربي نعاني من قلة الإبداع أيضا، فليس كل ما يُكتب بأهلٍ لأن يُقرأ، ولا كلُّ ما يُنشر بجدير بأن يُقتنى وتُنفق في قراءته الأعمار.
ولا شك أن الوعي المتزايد مؤخرا بأهمية اللغة القومية قد بدأ يؤتي أُكلَه، فإنك إذا رجعت إلى ثورة المدونات في بداية الألفية الجديدة ستجد أن معظم الشباب المغاربة كانوا يكتبون بالفرنسية، والأمر نفسه إذا عدنا إلى بداية ظهور الفيسبوك في 2008، كان الجميع أو الأغلب يدونون بالفرنسية، أقصد من الطبقة المتعلمة أو المثقفة. ثم آل الأمر اليوم إلى خلاف ذلك؛ صار التدوين بالفرنسية نادرا، ولم يعد لهذه اللغة وزن في الإعلام الموازي.
غير أن الذي ينبغي إثارة الانتباه إليه هو أن الخطر الذي يواجه العربية لم يعد يكمن في الفرنسية، ولا في أية لغة أجنبية أخرى كالإنجليزية -بل في رأيي أن هذه الأخيرة لو أتقنها المغاربة ستفتح لهم آفاقا أخرى جديدة، ولتخلصوا من أغلال الفرنسية التي توغلت في الإدارة والاقتصاد المغربيين- بل الخطر يكمُن في الدعوات الجديدة إلى مأسسة الدارجة، والذي كان يُهيَّأ له منذ مدة، بعد توجُّه الإعلام الرسمي إلى استعمال اللغة الدارجة، لا في البرامج الحوارية فقط، بل وفي الإعلانات أيضا، فقد انتقلنا من الإعلان بالعربية إلى الإعلان بالدارجة، وجميع الشركات اليوم تقوم بالإعلان بواسطة الدارجة، في انسجام تامٍّ مع الدعوات الأخيرة الداعية إلى مأسسة الدارجة، وإدخالها كلغة تدريس في منظومتنا التربوية، وهذا التوجه من شأنه أن يقطع كل الروابط التي تربط الإنسان المغربي باللغة العربية، وإذ ذاك لن يبقى له أي ذوق تجاه هذه اللغة، وكيف يتشكل لديه ذوق لغوي عربي، والعربية لا تطرق أذنه، ولا يسمعها، ولا يقرؤها إلا نادرا؟ والسماع شرط أساس لتنمية الملكات اللسانية. فهذا هو الخطر الأكبر والذي يجب أن توجه إليه سهام النقد، وأن يُحتاط منه كما يجب.
وعلاقةً بالتدوين، فيلاحظُ أن المدونين اليوم الذين كانوا يكتبون بالعربية صار جزء منهم -جزء كبير- يميل إلى التدوين بالدارجة، ذلك أنهم اكتشفوا أن التأثير الذي يُحدثه التدوين بالدارجة أكبر منه حين يكتبون بالعربية الفصحى. وشخصيا، مع حرصي الشديد على أن يكون ما أكتبه بالعربية الفصحى، فإني أنشر بالدارجة إذا تعلق الأمر بموضوع أريد لرأيي فيه أن يصل إلى أكبر عدد من الناس. طبعا لا ينبغي أن تكون مواقفنا من الدارجة متزمتة وعدائية، لأنها في النهائية هي وسيلتنا في التواصل اليومي، وإنما المشكلة فقط في مأسستها كلغة تدريس وإعلام رسمي يمثل الدولة والتوجه الرسمي.

ولا يمكن تفسير هذا التجاوب مع المكتوب بالدارجة إلا بضعف مستوى الغالبية من الناس في العربية، بحيث لا يسمح لهم مستواهم بقراءة مقال مكتوب بعربية محكمة. وقد يكون السبب راجعا أحيانا إلى أن الذين يكتبون باللغة العربية يتعمدون الإغراب في التعبير، فيأتي أسلوبهم غامضا غير مفهوم، وهذا يحدث كثيرا، فتجد الكاتب مولعاً بالإغراب في التعبير، وبالإكثار من الاستشهادات الشعرية والأمثال العربية القديمة، ليُضفي جمالية أدبية على النص، لكن المتلقي العادي لا يملك من الثقافة ما يؤهله لفهم هذا المكتوب. ولذلك فالحريصون على العربية ينبغي أن يختاروا عربية بسيطة، قريبة من الفهم، لا تثير قلاقل بالنسبة للقارئ العادي، حتى يتم جذب هؤلاء إلى ساحة العربية، وترسيخ الهوية اللغوية لديهم. طبعا، لا أحد يُعفيه انتماؤه إلى دولة عربية من تعلم اللغة العربية وبذل أقصى الجهد لتحسين مستواه فيها، فلم يعد هناك عربٌ بالسليقة، بل الكلُّ عربٌ بالتعلم، وقد انتهى زمن التلقي الفطري للغة. فلا بد أن نتعلم، وأن نحسن مستوانا في اللغة. واللغة ليست وسيلة تواصل فقط، بل هي أيضا وسيلة للتفكير، فنحن نفكر باللغة قبل أن نتواصل بها.
فاللغة، إذن، وسيلتنا للتواصل والتعبير عن مراداتنا التي بها تكونت في وعينا، وهما جانبان لا ينفصلان، وأهمية الفكرة لا تظهر إلا بإيصالها إلى الآخر، وهنا أشير إلى ظاهرة ملحوظة، وهي أن المفكر المغربي، مهما كانت قيمة الأفكار التي يحملها، لا يقوم بالدعاية والترويج لها بشكل كافٍ. فهناك مشاكل على مستوى التواصل والسعي للوصول إلى جمهور قارئ كبير، كما أنه لا يزال هناك حرص على العنونة التقليدية واستعمال لغة لا تتناسب أحيانا ومستوى المتلقي المتخصص، فضلا المتلقي العادي الذي لا دراية له بمصطلحات المجال. ومسؤولية المثقف أن يستدرج الناس العاديين إلى ساحته، ولن يتم له ذلك ما لم يكن قريبا منهم، ولن يكون قريبا منهم إلا إذا كانوا يفهمونه، ولن يفهموه ما لم يستعمل لغة قريبة إلى أفهامهم.
وختاما فإن أزمة الهوية اللغوية التي نعيشها في المغرب تَدفعنا إلى دق ناقوس الخطر، خطر الانسلاخ اللغوي، وخطر ضياع الهوية اللغوية والذوبان في هويات أجنبية عقيمة. وأن نذكر بأن الإبداع منوط باللغة، وأنها وسيلته ومظهره، ولن يتم ذلك لإنسانٍ خارج لغته الأم. وتتأكد هذه الأهمية إذا كانت اللغة في أصلها ذات خصوصية دينية كاللغة العربية، كونها وسيلتنا الوحيدة لفهم القرآن الكريم. كما ينبغي التذكير بأن خدمة هذه اللغة لن يتم بتخليد يومٍ عالميٍّ للغة العربية، على أهميته، كما أنه لن يتم خدمتها بواسطة الشعارات، وإنما بالعمل الميداني القريب من الناس، عبر الاشتغال بالنوادي والجمعيات، ونشر وتشجيع القراءة بها. وهذه كلها مهام الغيورين على هذه اللغة، المحبين لها، الواعين بأهميتها ودورها في النهضة المنشودة لأوطاننا.