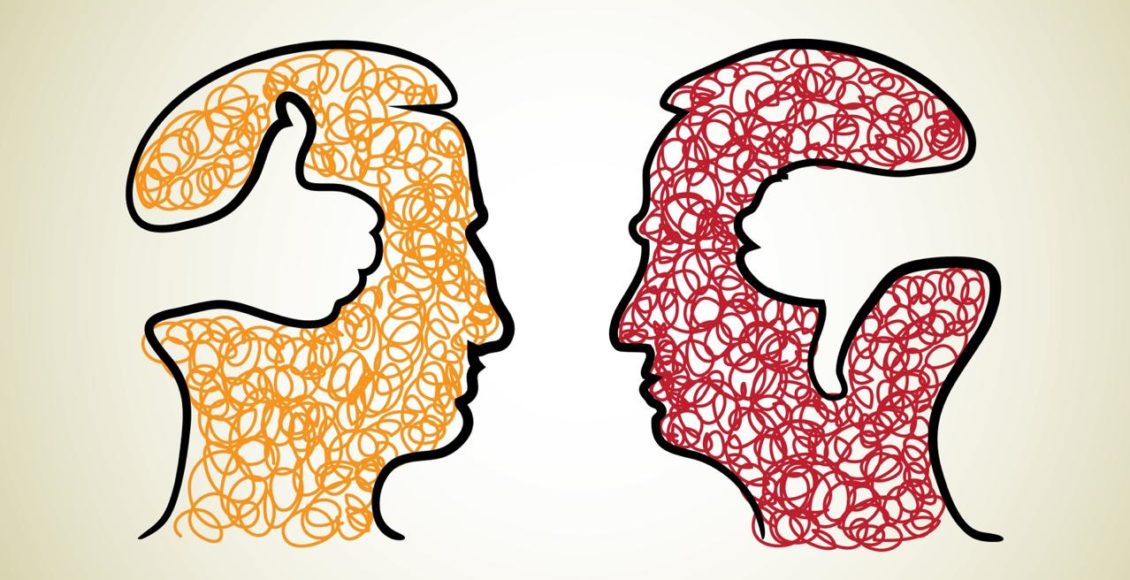ما مِن أحدٍ منا إلا وعاش تجربة الاستماع إلى شكوى أصدقائه وزملائه ومعارفه، وبوحهم وفضفضتهم عن مشاكلهم التي تؤرقهم، وتُعيق السير الطبيعي لحياتهم. بل إن بعض الناس أحيانا لا يطلبون لقاءك إلا ليشكوا إليك بثَّهُم وأحزانهم، التي ترجع غالبا إلى علاقات اجتماعية غير سوية. والإنسان كائن معقد، قد يُشفيه مجرد وجود شخص يستمع ويُنصت ويَهتم لما يقول. وقد جرى في أمثال العرب: “لا بد للمصدور أن ينفث”، وأن “الكيل تفيض عند امتلائها”، ومن ثم فهذا البوح غالبا ما يكون وسيلة للتخفيف عن النفس والإفصاح عن مكنوناتها، إلى أحد المقربين الذين يجيدون الاستماع. وفي هذا المقال محاولةٌ لتوصيف هذه الظاهرة، واقتراح لبعض الحلول لمعالجتها، والوقاية من الوقوع فيها.
لا شك أن الإنسان تأتي عليه لحظات يشعر فيها بالحاجة إلى أن يُفضفض لبعض الناس، المقربين منه، عن مشاكله، وسيكون من المكابرة أن ينكر أحدٌ كونه مرَّ من هذه التجربة. وشخصيا، كم من مرة وجدتُ فيها نفسي أميل إلى فعل الشيء نفسه مع معارفي وأصدقائي، ولا يمنعني منه إلا خوفي أن لا أخرج من ذلك بطائلٍ، بحيث أُفشي أسراري وهمومي، ومكنونات صدري، ثم لا يَرجع لي من ذلك فائدةٌ تُذكر، ولا قيمةٌ مضافة تُشكَر، فتكون الحسرة حسرتين: حسرة المشكلة الأصلية، وحسرة إفشائها الطوعي للناس. لأجل ذلك، ألجأ إلى الكتمان الذي هو في الوقت ذاته حرمان؛ حرمان من مشاركة الأحزان بغية التخفيف عن النفس. ولعل هذا الميل إلى الكتمان هو ما يَجعلني دوما في موقع المستمع والمنصت، والمطلوب منه المساعدة في إيجاد الحلول. وفي المشترك المعرفي الإنساني أن “أعظم الناصحين هم في العادة أشخاص خبِروا أكبر عددٍ من المشاكل وأعوصها”، بحيث تطرد جودة نصائحهم بعظم التحديات والمشاكل التي واجهتهم في حياتهم.
ولو أردت أن أجمل المشاكل التي يبوح الناس لي بها عادة، لأرجعتُها إلى أحد أمرين، فهي إما أن ترجع إلى العمل أو إلى العلاقات، وبالأخص العلاقات الزوجية والعاطفية.
فأما مشاكل العمل فأقصد بها تلك التي تواجه الشخص في رحلة بحثه الشاقة عن المال، الذي يلبي به احتياجاته الطبيعية والعائلية والاجتماعية. هذه المشاكل هي التي تجعل العامل يكره عمله ومهنته، حتى غدا أكثر الناس، اليوم، بحيث لو حصلوا على مبلغ كبير من المال، يؤمن لهم حاجياتهم لتركوا مهنهم ووظائفهم بأقصى سرعة ممكنة؛ ذلك أن العلاقة التي تربطهم بهذا العمل علاقة ملؤها المشاكل، ولا يجدون أي متعة فيما يقومون به.
فإذا انضاف إلى ذلك أن الكثير من الناس ينظرون إلى المال وكأنه الشيء الوحيد الذي يعطي المعنى لحياتهم، بل، أكثر من ذلك، تربطهم به علاقة تقديس، هي أقرب إلى أن تكون في منزلة تلك التي تربط المخلوق بخالقه. فتجد أحدهم يتحمل من المشاق ما لا يُطاق من أجل جمع المال، مخافةَ أن يأتي عليه يومٌ ولا يجد لديه مالاً، وخاصة إذا كان هذا الشخص قد تورط في قروض كبيرة وطويلة الأمد، بحيث تذهب أقساط مهمة من راتبه إلى تسديد هذه القروض؛ أو كان مدمناً على شيء معين، يستنزف مالَه، فيتحول هذا المسكين إلى آلة ميكانيكية لجمع المال، والذي يذهب بسرعة من جهة أخرى.
هذا الوضع يجعل الشخص يُضمر مشاعر سلبية تجاه المهنة وأربابها، وتتحول علاقاتُه في العمل إلى علاقات بدون روح، علاقات موغلة في السطحية. ويتحول العمل إلى نوع من الطقوس اليومية الجافة، والتي لا يَدفعه إليها إلا تلك المنحة التي سيتوصل بها في آخر الشهر.
والثقة في المال تقوى كلما صارت العلاقات الإنسانية أكثر هشاشة، بحيث لم تعد توفِّر ذلك الأمان الذي يوفره المال. فالإنسان الذي ينزل به المرض لا يتلقى العلاج اللازم؛ لأن مقتضيات الإنسانية تفرض ذلك، بل لكونه يتوفر على تأمين قوي، يسمح له بالعلاج في أعلى المستويات، أو لأن خزينة دولته تحتوي على ما يكفي من المال لتغطية نفقات علاج مواطنيها. فأصبح الناس يثقون في المال أكثر من ثقتهم في بعضهم البعض، وأصبحوا إلى المال أميلَ، أكثر من ميلهم إلى كل شيء عداه، إنساناً كان أو غيره.
وهذه خاصية للعصر الحديث كله، ولأجله صار الناس يميلون إلى إبرام عقود التأمين على كل شيء في حياتهم، حتى صرنا نسمع بأنواع من التأمين غريبة، كالتأمين على المؤخرة! ولا يَقدح في هذا أن نجد الأمريكيين مثلا يكتبون على الدولار: In God We Trust، لأنهم يعرفون، والعالم يعرف، أنهم لا يثقون إلا في الدولار وفي مؤسسات التأمين.
فالإنسان، إذ، قد تغيره الأيام، وقد يميل عنك لأسباب غير ذات أهمية، وقد يَضرب صفحاً عن ثقتك فيه، لكنك لن تجده أبداً يميلُ عن المال، وقد قيل: إن المال ما سمي مالاً إلا لأنه يستميل القلوب إليه، ويميل بالناس عن الحق. ولذلك صار المال قِبلةً لتوحيد وِجهات الناس، بل وخلَق عقيدة تحظى بالثقة عالميا. فالواثق في المال مؤمنٌ بعقيدة عالمية، يشاركه فيها أهله وجيرانه والعالم كله من حوله، لا يُستثنى من ذلك رجال دينٍ ولا رجال أعمال، فضلا عن غيرهم من الطبقات المختلفة من الناس، مهما كانت رتبهم الاجتماعية والثقافية، فهو، بمعنى ساخر، أهمُّ موحِّد للأديان، إذ لا يلتفت إلى اختلاف العقائد والأيدلوجيات أو الأعراق؛ فالكل في حبه يذوب.
إن ثقة الناس في المال واعتباره الضامن الحقيقي لاستقامة حياتهم واستمرارها، وحفظ مستقبل أبنائهم، أثرت على العلاقات الإنسانية، فحل محل العائلة القوية الروابط. وهذا ما يجعلنا اليوم لا نستغرب أن تقرر زوجة، في علاقة زوجية ناجحة، أن تطلب التطليق؛ لا لسبب إلا لأنها لا تستطيع التوفيق بين مسؤوليتها بوصفها زوجة وأما، وبين مسؤوليتها المهنية، فتقرر بكل هدوء واطمئنان التضحيةَ بعلاقاتها العائلية من أجل الحفاظ على مهنتها وراتبها؛ ذلك أنها لا تثق في الرابطة الزوجية ولا في العلاقات العائلية، وهي متيقنة أنها إذا احتاجت إلى المال يوماً فلن تجد من يُعينها ويَكفيها حاجتها. هذه القيمة المتزايدة للمال هي التي تجعل الناس يقبلون بعيش أقسى الظروف من أجل جنيه، والقبول بما لا يتوافق مع مبادئهم من أجل الحصول عليه، فصارت للمهنة قدسية، لأنها وسيلة إليه، بناء على أن للوسائل حكم الغايات، وأن المقارن للشيء مناسخ له. وهذا التقديس للعمل نتج عنه أن الناس، من أجل الحفاظ عليه، قد يضحون بصحتهم الجسمية أو النفسية.
وأما المشكلة الثانية فترجع إلى العلاقات الاجتماعية للشخص، سواء كانت علاقات الصداقة والزمالة بين الجنس الواحد، أو العلاقات مع الجنس الآخر، والتي في الغالب لا تكون إلا من طبيعة العلاقات العاطفية المعقدة أو قصص حب فاشلة.
ومن عجبٍ، فمع أن عدد الناس الذين جالستهم واستمعت إليهم في هذا الجانب كبير جدا، إلا أن قصصهم متكررة ومتشابهة بشكل يدعو للاستغراب. فلا تكاد تجد فرقاً كبيرا بينها، ما عدا ما يكون من تغير الشخصيات والأسماء، أو الاختلاف في السيناريو أو اختلاف الأدوار؛ وأما المحتوى والمضمون فواحد. ويتلخص غالبا في حالةٍ من الإحباط تصيب هذا الشخص أو ذاك، بسبب انصدامه وتفاجئه بما حصل، وكيف تغير عليه قريب أو حبيب بدون سابق إنذار.
وكل واحدٍ منا لو عاد إلى نفسه ونظر وتفكّر، لوجد أنه قد حصل معه شيء من ذلك، وأنه قد تجرع مرارة الخذلان أو خيبات الأمل في أشخاص مقربين إليه في يوم من الأيام، وأن سبب هذه المرارة ترجع إلى أنه كان يتوقع شيئا، فإذا بالذي يحصل حقيقةً هو شيءٌ آخر، سواء تعلق الأمر بعلاقات العمل أو علاقات إنسانية كيفما كانت طبيعتها.
وأنت لو فكرت قليلا لتبين لك أن جميع هؤلاء الذين تلتقيهم يوميا، وتُلقي السلام عليهم، وربما تتبادلون الضحكات والابتسامات، أو هؤلاء الذين تجمعك بهم علاقات عمل أو صداقة أو حب، هم أشخاص لهم توقعاتهم وانتظاراتهم وأهدافهم، وهم يبحثون عن الشعور بالرضى عن أنفسهم، وتطوير مستواهم، مهما كانت الأفكار التي ينطلقون منها، أو يؤسسون عليها هذا الشعور بالرضى.
هؤلاء الناس علاقتهم بك تنبني على هذا الأساس: إلى أي مدى وجودك في حياتهم مفيد لهم؟ ولا أحد من الناس في النهاية يمكنه القبول بك وبتقلباتك المزاجية، أو أن يضحي بسعادته وراحته النفسية من أجلك أنت، فقط لكي تُلبي احتياجاتك الأنانية وتكون سعيدا بحسب وهمك. ومعنى هذا أن أي شخص -ما عدا أمك- إذا كان يحاول مساعدتك لتشعر بالرضى عن نفسك، أو يحاول أن يجعل منك شخصا أفضل، فلأن مصلحته تقتضي ذلك، أو لأنكم تتبادلون المصالح، أو لأن هناك احتراما بينكما متبادلا تتأسس عليه علاقتكما، أو مشاعر وعواطف يُكنها كل واحد منكما للآخر، فتنبني عليها علاقتكما، ويجد كلٌّ منكما لذتَه ومتعته في إرضاء الآخر وجعْلِه سعيدا. وهذه الأخيرة – أعني العلاقات العاطفية- أيضا مبنية على منافع ومصالح، وإن كانت نفسية وعاطفية، إذ كل منكما يحقق إشباعا نفسيا وعاطفيا لديه.
وبعد؛
فأين تكمنُ المشكلة إذن؟
إن جذور المشاكل وأصلَها ورئيسها يعود إلى تلك الصورة الذهنية التي كوّنتَها عن الآخر، والتي لا تكون صحيحة في الغالب؛ فأنت من تلقاء نفسك تَخلُق له صورة ذهنية نموذجية، غير صورته الحقيقية، ثم تنتظر منه أن يكون مطابقا لها، فإذا تصرف بخلاف ما تقتضيه تلك الصورة الذهنية انزعجت وغضبت، وشرعتَ تلومه وتشكوه للناس. والمسكين في كل ذلك مظلومٌ، بل وقد لا يستطيع أن يستوعب: لِـمَ غضبت بتلك الطريقة؟ لأنه لا يستشعر أنه ارتكب خطأ ما، بل هو لم يرتكب أي خطأ أصلا.
ولعل هذا الأمر طبيعي مفهوم، فأنت في النهاية إنسان له عواطفه واحتياجاته، وتنتظر من الناس أن يقدروك وأن يهتموا لوجودك، ويَسرُّك أن ترى انعكاس قيمتك في أعينهم. فإذا كوّنتَ لشخص صورة ذهنية معينة، فلأنك شاركته تجارب معينة، وكان لكم تاريخ مشترك، وألِفْتَ وجوده في حياتك، وبوأتَه مكانةً في قلبك، فلما لا يأتي تصرُّفه منسجما مع هذه الصورة فذلك يُحدث مشاعر قلق وغضب لديك. وهنا تنشأ الاضطرابات في العلاقة بينكما إذا لم تكن واعيا كفاية بما يجب عليك الوعي به، وأولُه أن تعي أن الأشخاص لهم شخصياتهم ووجودهم الحقيقي المجرد عما تخيّلتَهُ أو كوّنتَه عنهم.
إن الخطأ في فهم الآخر ناشئ في الأصل من العجز الذي يعاني منه الكثيرون، وهو العجز عن التفريق بين ما نحب أن يكون الشيء عليه، وبين ما هو عليه في واقع الأمر. ومن ثم فنحن لا نحاول أن نفهم الشخص بالطريقة التي يرى بها نفسه، بل نحاول أن نجعله مطابقا لتصور مسبق في أذهاننا. والوعي بهذا الفرق يُعيننا في تدبير علاقاتنا بالآخرين. ومن الطريف أن هذا التمييز يعجز عنه بعض الناس حتى في محاولتهم لفهم ذواتهم، بحيث يتصورون أنفسهم تصورا معينا، ولكنهم في واقع الأمر هم بخلاف ذلك، ويحدُث لهم نوع من الانفصام والعجز عن التفريق بين ما يحبون أن يكونوا عليه، وبين ما هم عليه في الواقع. وتقليص الفوارق بين هذين المستويين يحتاج وقتا ومجاهدة طويلين.
إن سقف توقعاتنا من الأشخاص يرتفع بشكل مطرد مع مكانتهم عندنا، فإذا جاءت تصرفاتهم مخالفة لتوقعاتنا يكون ذلك صادما. ولذلك يلزم كلَّ شخص منا أن يكون صادقا في تقييم علاقاته بالآخرين، وأن لا يبالغ في تقديرها، بل يجب أن يعطيها مكانتها الحقيقية، لا كما أرادها أن تكون. ولعل هذا هو السبب في كون العلاقة بين الناضجين أكثر قابلية للاستمرار بشكل صحي، ذلك أن لهم وعياً بالتطور الذي يحدث للناس وهم يتقبلونه، كما أن لهم وعيا بأهمية الاستقلال الذي يبحث عنه الناس، ولذلك لا يكون سقف توقعاتهم من بعضهم البعض كبيرا.
ونخلص مما سبق أن منبع مشاكل الناس في علاقاتهم يمكن أن يختزل في التصورات الخاطئة عن الآخرين، تؤدي إلى توقعات غير مؤسسة، ينتج عنها إحباط وخيبة أمل في الطرف الآخر. وهذا الشعور بالإحباط يكون أكثر سوءا إذا رافقه شعور بالفراغ الذي ينتج عن وهم آخر، وهو وهم أن المال كفيل بأن يجعل منا أناسا سعداء، وهمُ أن راحتنا واطمئناننا يتوقف بشكل أساس على المال، أو على شراء سيارة فاخرة أو أي شيء آخر مما يتباهى الناس به عادة، أو وهمُ أن وجود شخص معين في حياتي، كالزواج من فتاة معينة، يؤدي بالضرورة إلى سعادة أبدية في حياتي. هذه الأوهام كلها تؤدي إلى شعور مرير بالإحباط، لأنها توقعات محكومٌ عليها بالخيبة.
إن هذه الأوهام قد تُغرّر ببعض الناس، فتحملهم على اقتراض مبالغ طائلة بفوائد كبيرة، ومن ثم يرهنون حياتهم بأسرها، فقط من أجل شراء منزل في حي فاخر، وهم يتوهمون أن السكنى في ذلك الحي ستجعل منهم أغنياء، أو سترفع من منسوب سعادتهم، والحال أنهم يكتشفون، بعد حين، أنهم دخلوا متاهة من السعي الذي لا ينتهي وراء المال، لتسديد أقساط القرض. والكثير يموتون دون أن يتمكنوا من تسديدها كلها. ولو تساءلت: لم يُقدم الناس على ارتكاب مثل الحماقات القاتلة؟ ستجد أنهم دُفعوا إليها، بناء على تصورات غير حقيقية، توقعاً لأمور لن يجدوها، لأنهم بحثوا عنها في غير محلها.
فالكثير من هؤلاء المغرر بهم، ينجحون في تحصيل ذلك الشيء الذي توهموا أن سعادتهم تتوقف عليه، لكن لا يشعرون بأية سعادة أو تغيير في حياتهم، فيعاودهم شعور الإحباط المرير؛ لأنهم عاشوا حياتهم وهم يجرون وراء السراب، وبعد طول عناء لم يتحصَّل لهم من ذلك ما يشفي العليل أو يروي الغليل، ثم يكتشفون، متأخرين، أن مشكلتهم في ذواتهم، في كونهم لم يتعمقوا في فهم ذواتهم، ولم يرتقوا بشخصيتاتهم، ولم يقوموا بإغنائها، وقضوا معظم حياتهم في العمل، وعاشوا حياتهم كلها بشخصيات هشة جوفاء لم يستثمروا فيها روحيا ومعنويا، ولم يعيشوا تجارب كافية لإنضاجها. عاشوا أسرى الوهم، ولم يستفيقوا حتى فات أوان الاستدراك، وفاتهم القطار، “وأصعب ما في القطار الفواتُ”، كما يقول الشاعر السوداني الجميل محمد عبد الباري.
وفي الختام، فلكل شيء ثمن، وثمن هذا الوعي المتأخر هو كل ذلك الألم والأوجاع والأذى الذي تحملوه لسنوات. نعم هو درس قاس: النقص الداخلي لن يملأه شيء خارجي، مهما كان هذا الشيء. البحث عن السعادة يجب أن يكون في ذواتنا، والاستثمار ينبغي أن يتوجه إليها، والفراغ الداخلي حاجز عن كل شعور بالمعنى، بالإنجاز أو بالرضى وبالاطمئنان.
فما أخلقَنا بتركيز الجهود على دواخلنا وذواتنا، وأن نكفَّ عن الاعتقاد بأن المال سيُغنينا إن كنا فقراء الروح، فرُبَّ حارس فيلا فاخرة، يعيش حياةً ملؤها الرضى والاطمئنان والهناء والسكينة، في الوقت الذي لا يستطيع مالكها أن ينام إلا بعد تناول حبوب منومة. وقد كان المسكين يظن أن الأموال كانت ستستعده وستغنيه، وسترفع من قيمته أمام الناس، فلما كدّس منها ما كدس، بعد أن كلفته صحته وأغلى أوقات عمره، اكتشف أن توقعه لم يكن في محله، وأن جهاده كان في غير عدو، ليكتشف في آخر الأمر أن توقعاته لم تكن موافقة لطبائع الأشياء، وأن ذاته أفرغ من أن يملأها شيء، وأن الناس لم يُخلَق منهم أحد فقط لتلبية احتياجاته الأنانية وتوقعاته الساذجة.