كل التقارير والإحصائيات التي تُنشر حول موضوع هجرة الأدمغة المغربية إلى الخارج تُجمع على أمر واحد، وهو دقُّ ناقوس الخطر، والتنبيه إلى الخسائر الفادحة التي يتكبدها المغرب بسبب هجرة أدمغته وكفاءاته، الأمر الذي ينتج عنه حتما ازدياد الفجوة بينه وبين الدول التي تقوم باستقطاب هذه الأدمغة والكفاءات، وفي مقدمتها دولة فرنسا. ففي دراسة نشرتها مجلة THE Arabe weekly أتى المغرب من ضمن ثلاثين دولة تعتبر الأعلى تصديرا للكفاءات العالية إلى الخارج. كما أن وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي المغربية اعترفت أن 600 مهندس مغربي يغادرون هذا البلد سنويا، وهو رقم كبير جدا؛ لأنه يكاد يساوي العدد الإجمالي للمتخرجين سنويا من معاهد ومدارس الهندسة في المغرب.
ومنذ أزيد من عشر سنوات، حاول المغرب التقليل من حجم الخسائر التي تنتج عن هجرة هذه الكفاءات، وبالضبط منذ 2007، من خلال تأسيس المنتدى الدولي للكفاءات المغربية المقيمة بالخارج (FINCOME) وهو برنامج يسعى إلى جذب وإعادة المهنيين والكوادر والأكاديميين المغاربة الذين يقيمون ويعملون بالخارج إلى المغرب، والاستفادة من خبرتهم، ومحاولة إدماجهم في قطاعات التعليم العالي والبحث العلمي وقطاع الأعمال في وطنهم، وجعلهم يُسهمون في تنمية وطنهم. إلا أن هذه المساعي لم تؤت أكلها لأسباب موضوعية، ترجع أساساً إلى التفاوت في الفرص المتاحة في المغرب وفي تلك الدول المهاجَر إليها، وإلى الاختلاف في ظروف العمل والحقوق المكتسبة للعمال، بالإضافة إلى التباين في الرواتب والحوافز والتعويضات المالية.
وموضوع هجرة الأدمغة ليس موضوعا حديثا، ولا مشكلا مستجدا في السنوات، بل منذ أن وعينا ونحنُ نسمع كلاما مكرورا عن هذا الموضوع، كما كنا نحن أيضا نكرره عندما نُلزَم بكتابة مواضيع إنشائية في فترة التعليم الابتدائي والإعدادي، وفقا لذلك المنهج المألوف المقسم إلى قسمين: المشكلات والحلول. كنا حينها نقدم حلولا جاهزة، بعفوية الأطفال الذين لم يخبُروا الحياة، وقد غُرس فينا فطرةً حبُّ الأرض والتمسك بالانتماء إلى الأرض. وبدا واضحا أن الموضوع سيكون ساخراً بشكل ما، لأن من عيوب أن يكون المرء طفلا صغيرا أنه لا يظلُّ كذلك، بل يكبُر ويتغير منظوره للأمور كلية. فلم يمض إلا وقت يسير حتى كبُرنا، وصرنا بدورنا نفكر في الهجرة إما بحثاً عن تكوين ودراسة أفضل، أو بحثا عن العمل ومستوًى من العيش أليق وأمثل.
ولأننا في عالم قد أصبح قريةً صغيرة فهذا الحديث حول هجرة الأدمغة لن يتوقف، بل سيظل يتزايد يوماً بعد يوم. وسيتجدد كلما طالعتنا وسائل الإعلام بخبرِ مغربي ــ من حينٍ لآخر ــ وهو يقود مشروعا علميا كبيرا، بتمويل ضخم جدا، ويراقبه الملايين من مختلف أرجاء العالم؛ وكلما تألق نجم مغربي في نادٍ أوروبي معين، أو تفوق مترشح مغربي في مسابقة علمية خارج المغرب. إن قدَر الحديث عن هذا الموضوع أن يتواصل ولا ينقطع، ومع ازدهار النشر على مواقع التواصل الاجتماعي يمكننا أن نتنبأ باتساع دائرة المنخرطين في التنظير لهذه الظاهرة.
لكن، ومهما يكن، فلا ينبغي أن يكون المهاجرون هم الذين يقع عليهم اللوم، كونهم فضلوا بلادا أخرى على بلادهم التي نشّأتهم وربّتهم وكوّنتهم حتى أصبحوا ما أصبحوا عليه؛ ذلك أن من خصائص الإنسان أنه كائن رشيد، يسعى دائما إلى تعظيم منفعته. وهو ما جعله يتطور خلال قرون مضت؛ فلولا ترشيد الإنسان لسلوكه لبقي في المرحلة البدوية. والأمر كذلك ينطبق على الإنسان في هذا العصر، فالكل يسعى إلى تحسين وضعه المادي والمعنوي. وذلك غير معيب على الإطلاق؛ بل عكسه هو المعيب، وهو الرضا بأقل الممكن، والانقياد إلى الأمر الواقع. فهؤلاء المهاجرون إذن، المفروض أنهم من الكفاءات العالية، هم أناس يتصرفون وفقا لما يقتضيه قانون العقل، وتقتضيه الفطرة. وهو السعي إلى الأفضل والأمثل والأليق، بحسب الطاقة والاستطاعة. فلا لومُ هؤلاء ولا التباكي على الواقع سيغير من هذه الظاهرة شيئا، كما أن الكلام المكرور والوعود الزائفة لن تُعيد الثقة لمن فقدها، ولن يعيد المهاجر الذي توفرت له كل الظروف الجيدة للعيش في دولة أخرى.

ومن أجل معالجة هذه الظاهرة والإبقاء على تلك الكفاءات في المغرب، سيحتاج الأمر عقودا من الزمن، لبناء المؤسسات الضرورية التي يمكن أن تشتغل فيها تلك الكفاءات، وتحسين ظروف الشغل فيها، والزيادة في الرواتب واعتماد سياسة التحفيزات المالية في العمل، من أجل رفع المردودية، وعدم الاقتصار على راتب موحَّد يعطى للمجتهدين والكسالى على حد سواء. فمن دون توفر هذه الشروط، سوف تختطفهم دول أخرى لها قدرة على توفير الشروط السابقة، خاصة في ظل حرية التنقل الذي أصبح مبدأ مقدسا في العصر الحديث؛ حيث لا يمكن أن يُمنع شخص من مغادرة وطنه بدون أن يكون قد اقترف ما يوجب ذلك. وكون الشخص كفاءة من الكفاءات العالية ليس جرما يمنعه من مغادرة وطنه.
وهذه خلاصة الكلام في القضية من وجهة نظري. ويمكن أن يتم تنزيل هذا الكلام على أي كفاءة من الكفاءات المغربية التي تظهر في هذه الدولة أو تلك، بين فينة وأخرى. ولا يحتاج الأمر أن نضفي عليه سيلاً من مشاعر الوطنية الزائفة، أو أن نلوم الآخرين على اختياراتهم الرشيدة، أو أن نشكك في صدق انتمائهم أو نحاول أن ننفي عنهم صفة الوطنية، وأن نجردهم من “تامغربيتهم”. فليس ذلك من حق أي أحد. والعجب كل العجب أن من يقترفون مثل هذه التصرفات ويشككون في انتماءات الآخرين، لو أتيحت لهم فرصة مغادرة هذا الوطن إلى ما هو أفضل منه لمـَا ترددوا للحظة واحدة، ولأقدموا على ذلك بعينين غامضتين، كما يقال.
وعوداً على بدء؛
فقد شهد المغرب في الآونة الأخيرة جدلا كبيرا حول البروفيسور المغربي الشهير منصف السلاوي الذي عينه الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب لقيادة فريق طبي كبير في الولايات المتحدة يعمل على إيجاد لقاح فعال ضد كورونا. وانقسم المغاربة حوله إلى قسمين؛ قسم يدافع عن هويته المغربية، ورأوا في إنجازه وتعيينه لقيادة هذا الفريق الطبي الكبير فخرا لكل المغاربة في جميع بقاع العالم. فالمغربي يظل مغربيا حيثما وُجد، وأينما رحل وارتحل. ومهما أخذ من جنسيات أخرى بعد ذلك، فهو يظل مغربيا قد ولد على هذه الأرض، وأكل من خبزها، واستنشق من هوائها. وكل إنجاز يحققه فله إلى وطنه انتساب، يحق لأهله أن يفخروا به. وأما الفريق الثاني فيحاججون بأن هذا الرجل رغم كونه مغربي المولد والأصل والجنسية، إلا أن تكوينه وتميزه وعبقريته ما ظهرت على هذه الأرض، وإنما في بلد آخر. فما حققه يرجع إلى الظروف التي وفرتها تلك البلدان له، والتي منحته جنسيتها، ووفرت له كل الإمكانيات اللازمة للنبوغ والتميز؛ فهو إلى الانتساب إليها أقرب وأحق. ولا شك أن وطن المرء حيث يجد نفسه ويحقق ذاته وطمأنينته وأمنه.
والحقيقة أنني لست متفاجئا ببروز خبير كبير في الأوبئة، يحمل جنسية مغربية، وأخذ البكالوريا في ثانوية مغربية، ولستُ متفاجئا كذلك من الخلاف والانقسام حوله. لكن المفاجئ لي حق هو التباكي الذي لجأ إليه بعض الناس، والتحسر على ضياع تلك الكفاءة وعدم الاستفادة منها في المغرب. وخاصة حين يأتي مثل هذا التصرف من أشخاص يتحملون مسؤوليات في الدولة، ويعلمون الوضعية المزرية في مؤسساتنا العلمية، وخاصة منها الطبية. ولكن هذا النفاق ليس غريبا علينا، فقد عايشناه ونحن طلبة في كلية الطب، وحتى بعد أن تخرجنا منها. فلا زلت أتذكر أنني منذ بضع سنوات، كنت مدعوا للمشاركة في محاضرة نظمتها جمعية في كلية الطب والصيدلة بالرباط، كان موضوع اللقاء حول: كيف تكون طبيبًا مؤثرًا في المجتمع ؟
تحدث المتدخلون كلٌّ من منظوره الشخصي، ولما حان دوري شرعت في الكلام. ولأنني بين زملائي وفي رحاب كليتي، فلم أكن ألوك الكلام لوكا، ولا أزيف واقعا معروفا. بل تحدثت بكل صدق وأمانة، معبرا عما أعتقده، فنصحت زملائي ــ أطباء الغد ــ بضرورة الاجتهاد وبذل غاية الوسع من أجل التحصيل العلمي المتين، الذي يؤهلهم لأن يكونوا أطباء أكفاء، لهم سمعة طيبة في المجتمع، ولهم تأثير إيجابي فيه. وكان من تمام الأمانة والصدق أن أنبههم إلى أن من أراد منهم أن يبلغ درجات عليا، ويحصل على تكوين أفضل يجعل منه خبيرا متميزا في الأمراض والأوبئة الفتاكة على مستوى العالم، فعليه أن يُتم دراسته في بعض الجامعات الكبرى في الخارج إذا استطاع إلى ذلك سبيلا، حيث يتم استثمار ميزانيات ضخمة في البحث العلمي وتكوين الأطر. ولم أكن أحسب أن هذا الكلام سيثير غضب أحد، لأنه يكاد يكون معلوما للجميع. إلا أنني تفاجأت بأستاذة مبرزة في الكلية تشتاط غضبا، وتخطف مكبر الصوت من يدي، وتأمرني بالاعتذار عما قلتُ، بدعوى أنني أسيء إلى الجامعة المغربية، وأحرض على هجرة الأدمغة.
لم تنتبه الأستاذة الكريمة أن تصرفها هو الذي يمكن أن يؤدي إلى هجرة الأدمغة، لأنه كان في غاية السماجة وقلة الذوق والاحترام وفقدان البصيرة والحكمة؛ فعلى فرض كوني مخطئا ــ ولا أظن ذلك ــ فإنه ما كان ينبغي أن تتصرف على تلك الشاكلة، بل كان عليها أن تنتظر حتى أنتهي من كلامي، وتطلب تعقيبا تبين فيه أنني أخطأت التقدير، ثم تترك الأمر في الأخير للطلبة ولقناعاتهم، فليسوا بأطفال قاصرين لا قدرة لهم على التمييز، بل هم طلبة جامعيون راشدون مسؤولون، لهم القدرة على الاختيار، وهم وحدهم من يتحملون مسؤولية ذلك الاختيار. لم تكتف الأستاذة الكريمة بزجري فقط ومقاطعتي وأنا أتحدث، بل شرعت تصور المدارس والجامعات المغربية وكأنها تتحدث عن بلد آخر غير المغرب الذي نعرف، بل توهمتُ للحظة أنني أمام إيليزابيت هيلين بلاكبورن وهي تمجد في جامعة كاليفورنيا، التي عملت جاهدة لتوفير كل المستلزمات لاكتشاف أنزيم التيلوميراز.
من الطبيعي أن أتفاعل مع الأستاذة الكريمة دفاعاً عن قناعاتني، لكن وبعد مرور سنوات على هذا الحادث، عدتُ أتساءل: هل نُصح الطلبة بالبحث عن آفاق أوسع، وتكوينات أفضل، هو تحريض على هجرة الأدمغة؟ ما هو المنطق الذي نريد من طلبتنا اليوم أن يفكروا وفقا له؟ هل السعي إلى الأفضل أم الاحتماء بالمشاعر الزائفة والأوهام المكشوفة؟
لو عاد بي الزمن إلى الوراء، لربما عبرتُ عن فكرتي بطريقة أفضل، لكن ما أراني سأغير من جوهر الفكرة. فلا زلت إلى اليوم أنصح الطلبة بالبحث عن الأفضل، وأرى ذلك صوابا، وهو ما ينبغي أن يكون. فمن النواقص عندي أن يرضى المرء بأقل مما يستطيع. وتلك كانت حكمة شاعر العربية الكبير، أبي الطيب المتنبي:
ولم أرَ من عيوب الناس عيباً كنقص القادرين على التمام !
وعلى كل حال، فالواقع واقع، يصعب إخفاؤه بكلام رنّان. والواقع يقول: إن أكثر من 6150 طبيبا ولدوا في المغرب، وهم يعملون الآن في دولة فرنسا وحدها. وهذا يعني أننا نصدر إلى فرنسا لوحدها ضعفي ما تتوفر عليه مستشفياتنا العمومية من أطباء، وهو أمر دالّ. والسؤال المطروح: هل يرغب هؤلاء في الهجرة عبثا؟ لا بد أن الأمر له تعليل معقول؛ فلا أحد يترك بلده وعائلته لكي يكون مهاجرا في بلد آخر، إلا لسبب معقول جدا. وليس هذا السبب إلا ما ذكرناه آنفا من توفر بيئة ملائمة للعمل، ووجود حوافر للاجتهاد والعمل.
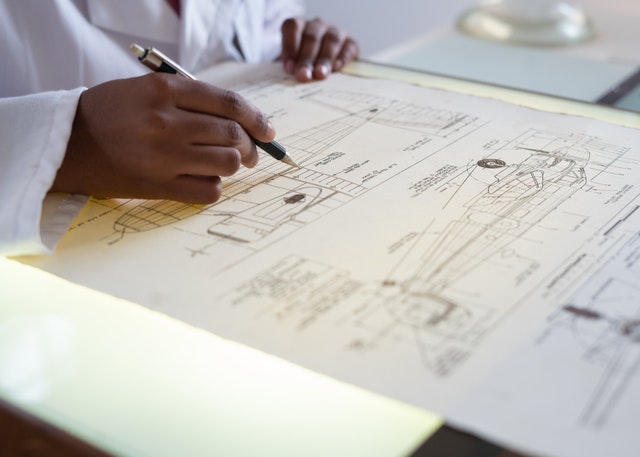
نعم، بلدنا يزخر بطاقات خيالية، وكوادر عالية، وقد شهدتُ بأم عيني أطباء مختصين في الجراحة لهم أكفاء ومتميزون، كانوا يحلمون بأن يصبحوا أساتذة، ولم يُعطَوا الفرصة، كان مصير الكثير منهم أن أُقبروا في مستشفيات عمومية إقليمية فارغة، لا تتوفر على الحد الأدنى من الإمكانيات والمعدات اللازمة للعمل، فضلا عن وجود بيئة محفزة، تجعلهم يحافظون على رغبتهم في التميز. وكانت النهاية أن أصيب بعضٌ منهم ممن أعرف بالاكتئاب المزمن، وآخرون أصبحت أكبر أمنياتهم أن يعملوا في مصحة خاصة، بعد انتهاء عقدة عملهم مع القطاع الحكومي.
وخلاصة القول أن المشكل في نظري له وجهان:
– الوجه الأول يمثّلُه هذيانٌ مزمن وهلوسة يؤديان إلى تفكير مشوش وانفصال تام عن البيئة المحيطة، كأن نقول بأن “المغرب أجمل بلد في العالم”، كما نسمع من حين لآخر، دون بيانٍ لموضوع الجمال فيه، ودون بيان كون أجمل: نسبةً إلى أي بلد؟ والمغرب لا يمكن إلا أن يكون أجمل بلد في العالم عند مَن لم يخرج من حيه الذي وُلد فيه؛ لأنه لم يرَ غيره ولم يزره. ومن البديهي أن أوصاف: الأفضل والأجمل والأحسن لا تكون بالتمني، ولكن بالإحصائيات التي تبين رتبة الدول بحسب معدل التنمية البشرية، والأرقام التي تبين مستوى البطالة والأمية ومستوى العيش وغيرها. وهي للأسف الشديد لا تساعد على نسج هذه الخيالات حول بلدنا، الذي نرجو له كل خير، من غير ما شك. لكن، يجب أن لا نختلق الأوهام المريحة، ونتغاضى عن الحقائق المزعجة.
– الأمر الثاني هو قدرة بعضٍ منا الغريبة على الانسلاخ من كل ما يشكل انتماءهم للمغرب بمجرد إيجاد بديل آخر وتعليقات بعض المغاربة حول تعيين منصف السلاوي من طرف الرئيس الأمريكي السابق، ووصفهم إيّاه بأنه ليس مغربياً خير مثال على هذه القابلية لضرب كل ما يمت بالمغرب عرض الحائط بمجرد إيجاد مستقبل أفضل في بلد آخر وفي ظروف أخرى. وينبغي لهؤلاء أن يعلموا أن الوطن ليس بتلك الظروف التي يعيش فيها مواطن معين، وليس بذلك الشخص الذي زجرك يوما ما، سواء كان والدك في البيت أمام الضيوف، أو أستاذك في الجامعة أمام زملائك، وليس بذلك الذي ألزمك على اختيار مهنة ما، أو ألزمك على البقاء فيه أو مغادرته.
نعم، إن المشكل ليس في المغرب ــ البلد والوطن ــ الأرض التي عشنا فوقها لسنوات حتى أصبحت جزءا من كياننا، ورسمت خريطتنا الذهنية وجزءا كبيرا من ثقافتنا. إن المشكل أساسا في كوننا لا نعمل على الارتقاء بهذا البلد حتى يكون قِبلة للكفاءات من كل بقاع العالم، وليس مُصدّرا لها. المشكل في كوننا لا زلنا نحسب أن قول الشيء وفعله سواء، وأن مجرد القول يُغني عن الفعل؛ فيكفي لمسؤول معين أن يتحدث عن مشكل حتى يشعر أنه قد برّأ ذمته، وليس بحاجة إلى العمل على الإصلاح؛ المشكل فيمن لديهم قابلية شديدة وسريعة للانسلاخ من كل إرث يربطهم بوطنهم؛ المشكل في أشخاص بيننا يعتقدون أن الوطنية شعار وليست شعوراً، وأن بإمكانهم أن يُجردوا أيَّ شخص من هذا الشعار متى شاؤوا.
أجل، “الوطن ليس فندقا نغادره عندما تكون الخدمات سيئةً”، و أن الواجب هو العمل على إحسان الخدمة. لكن لا يمكن أن يعاب الطلبة إذا بحثوا عن تكوين أفضل، ولا أن يلام المتخرجون إذا بحثوا عن ظروف عمل أفضل. حين يكون المشكل بنيويا، فيجب أن يتم إصلاحه من الأساس، لا أن تزخرف السقوف؛ لأن السقف وإن كان مزخرفا، إذا كان من غير أساس متين سينهدم على رأس صاحبه. فما يُفيد أن نزين الواقع في تصور الناس وفي أذهانهم إذا لم يكن هو كذلك في نفس الأمر؟ إن المشكلة الأكبر أيضا فيمن ينسلخون من الواقع ويدخلون في حالة من الهذيان يُسكتون بها ألم الواقع، فيصورون الوطن على أنه أم الأوطان وأجمل البلدان، وأنه بلد وفرة وسلام.
وخاتمة القول أن الأفضل ممكن، وأن طريق الإصلاح لا تزال طويلة، بل لعلها لم تبدأ بعدُ، ونحن مَن علينا أن نخوض هذه الرحلة. هذا الوطن أمٌّ ولُودٌ، بلد معطاء وغني. ولكن من غير العمل الجاد، ومن غير الصدق في القول والعمل، ومن غير التخلص من عقدة الاعتراف بالواقع، سنظل نراوح مكاننا. وكل جيل سوف يكرر ما كان الجيل الذي قبله يكرره. لِنتذكّرْ أن لا شيء أفضل من الصدق. والحقيقة دائما جميلة، حتى وإن آلمت. فقط؛ لأنها حقيقة.


