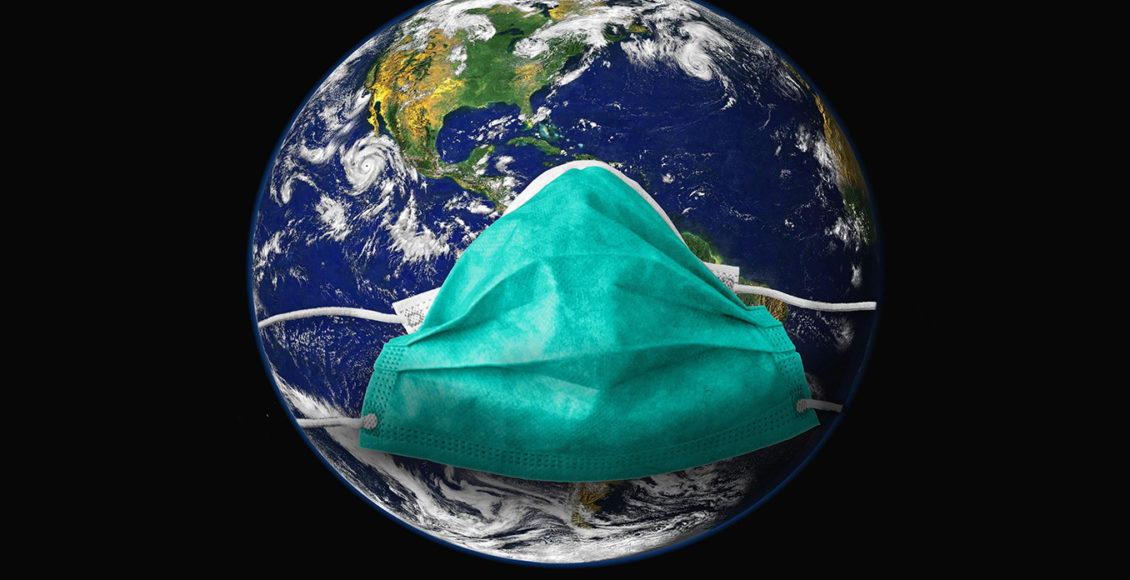بعد مرور أسابيع على بدء انتشار الفيروس خارج الصين، بدأ العالم يتعرف على هذا الفيروس شيئا فشيئا. لكن، وقد مر وقت غير قصير، ما زال الكثير من الأسئلة معلقا من دون إجابات. نعم، من الناحية النظرية، هذا الفيروس قد انتقل من الخفاش إلى آكل النمل الحرشفي، فمنه إلى الإنسان، ثم انتقل بعد ذلك بين بني البشر بسرعة قياسية، لم يعرفها أي فيروس آخر سابق. غير أنه يصعب أن يصدق المرء هذه السردية ويتوقف عن طرح الأسئلة بسهولة. فهذه المعطيات لا تغطي كل شيء من جهة، كما أنها غير مثبتة بالأدلة العلمية إلى الآن من جهة ثانية.
وقبل أن أتابع كتابة هذا المقال، أحب أن أنص بداية على أنني واعٍ كل الوعي أن نسبة احتمال إساءة فهم هذا المقال تظل كبيرة إلى حد بعيد. لكن بوجه ما، إنما تكتب الكتب ليُساء فهمها. وقرار الكتابة عن هذا الفيروس يقتضي مني أن أشارك القارئ الكريم كل الآراء والتساؤلات التي تكونت عندي بخصوص هذا المستجد الوبائي المفاجئ. وإن كنت أعرف مسبقا أن بعض هذه الآراء لن يُنظر إليه بعين الرضى من طرف فئة غير يسيرة من القراء. وربما يصنفها بعضهم في خانة التفكير الخرافي المتجاوز، وبعضهم قد يراها تنتمي إلى التفكير الميتافيزيقي، ولا تمت إلى الموقف العلمي بصلة.
لعل التساؤل الأول يبدأ منذ ظهور هذا الفيروس؛ ما الذي حدث ليؤول في النهاية إلى هذا الذي نعيشه اليوم؟ ما السبب الأول في ظهور هذا الفيروس؟ هذا هو السؤال الأكثر إلحاحا على من يهتمون بفهم ما يجري، منذ بداية هذا الحجر الصحي. وهو السؤال الذي يستتبع جملة من أسئلة أخرى، والتي تدل على وجود أشياء كثيرة متعلقة بهذا الفيروس غير مفهومة، بل ومثيرة للريبة أحيانا.
لا يمكن للمرء أن يذهب بعيدا ويزعم أن هذا الفيروس قد يكون من صنع البشر، كما أرجف بذلك الكثيرون. لا لأننا لا نملك دليلا على ذلك فقط، ولا لأنه ليس أخلاقيا، يمتنع تصور الإقدام عليه من طرف جهة ما لها مصلحة في ذلك، بل وأيضا لأن صناعة فيروس ينتقل طبيعيا بهذه الطريقة أمر، يظل في غاية الصعوبة من الناحية العلمية.
المعلومة العلمية المتوفرة حاليا هو وقوع طفرة في فيروس ينتمي إلى عائلة الفيروسات التاجية، سمحت له بالانتقال من جنس إلى جنس، ومن ثم إلى بقية الأجناس البشرية. وإذا سُلم هذا، وينبغي أن يسلم، فيبقى التساؤل حول التوقيت: لماذا الآن، مطلع السنة الجديدة، وليس قبل ذلك أو بعده؟ كيف اكتسب هذه القوة في الانتشار السريع، بطريقة تعتبر شيئاً بِدعاً في تاريخ الفيروسات التي عرفتها البشرية؟

إن طرح السؤال بصيغة: “لماذا”، هو بحث عن التعليل وبحث في الدوافع. وهو غالبا ما يؤول في القضايا الملتبسة والمبهمة إلى الانسياق وراء نظرية المؤامرة. وتفسير أي شيء بالمؤامرة، مع أنه قد يصح في أحيان قليلة، ليس أمراً علميا، ولا موقفا نظريا سديدا. والمغري في نظرية المؤامرة أنها تحدث ارتياحاً لدى المؤمنين بها، وتعطيهم فرصة لتفسير الأمور بالطريقة التي يحبون. ولذلك من المهم أن لا ينساق العاقل إلى التفسير بالمؤامرة، مع أن المؤامرة في عالم البشر قائمة، ولا ينكر وجودها إلا مغلوب على عقله. ومن السديد أن نميز بين نظرية المؤامرة كموقف نظري تفسيري لكل شيء، وبين المؤامرة نفسها بوصفها سلوكا قائما في عالم البشر.
بعد هذه المقدمة الضرورية نمضي إلى تسجيل ملحوظات سريعة حول انتشار هذا الفيروس، مع التأكيد على أن هذه المقالة كُتبت في منتصف أبريل، وقد تتغير بعض المعطيات المثبتة فيها بمرور الوقت.
إن الملاحظ منذ أكثر من أربعة أشهر من الانتشار العالمي لهذا الفيروس، أنه لا يقتل الأطفال إلاّ نادرا جداً؛ وأنه يستهدف في المقام الأول البالغين المكلفين، مع وجود علاقة طردية بين الزيادة في العمر ومعدل الوفاة؛ وأنه يفتك بأكثر الدول تصنيعا وتلويثًا وتخريباً للبيئة، وهو ما زال إلى الآن رحيما إلى حد كبير بالدول الضعيفة، المثقلة بالقروض والاتفاقيات، التابعة في مواقفها وقراراتها السياسية والاقتصادية، بالإضافة إلى أن هذا الفيروس لا ينتقل بتاتا من الإنسان إلى الحيوانات، وإن كان أصله حيوانيا. فهذه مجمل الملحوظات التي يمكن استنتاجها من انتشار هذه الجائحة لحدود كتابة هذه الأسطر، وهي ملحوظات إحصائية بالأساس.
وانطلاقا من هذه الملحوظات، لا يستطيع المرء أن يخفي أن شيئا ما في الطبيعة يتمرد على الإنسان بذكاء بالغ، وأن هذا الذي يحدث يبدو وكأنه يقصد إلى غاية ما، هي الانتقام للطبيعة. وكأن هناك قوة غريبة موجهة نحو الإنسان البالِغ المُكَلف، وحده دون غيره من الكائنات، وكأن محكمة السماء تقتص للطبيعة التي شوهها جشع الإنسان. ثمة شيء ما ينتقي بطريقة جراحية دقيقة المسؤولين عن كل الجرائم التي ارتكبت في حق الطبيعة؛ أعني الإنسان البالغ المنتمي إلى المجتمع الصناعي الرأسمالي الاستهلاكي، الموغل في الأنانية وحب الذات، والميل إلى استغلال ونهب خيرات الآخر. جرثوم مجهري لا يرى بالعين المجردة استهدفه بمفرده، عزله عن الآخرين، أوقف اقتصاده؛ وأجبره على إعادة النظر في نمط حياته. فيروس تسلل إليه بواسطة كائن مجهري ينتقل في تفاصيل الحياة؛ المصافحة والعناق، القبل، العطاس، الكلام، النقود، والأسطح وفي كل شيء يلمس تقريبا. فلا يدري الإنسان متى يصاب، ولا يكتشف أنه مصاب حتى يكون الفيروس قد فعل فعلته، وخرب رئتيه أو يكاد، وحينها يبدأ تنفسه يضيق شيئا فشيئا، وترتفع درجة حرارة جسمه، ويبدأ الألم في رأسه يشتد شيئا فشيئا، ثم هو في النهاية قد ينجح في التغلب على الفيروس بعد ذلك وقد يفشل، لا قدر الله. فهل يكون هذا عقابا للإنسان عن تشويه الحياة على هذا الكوكب، عن طريق تخريب الطبيعة المتواصل؟
في الواقع، ليس يُهم الجواب عن هذا السؤال بالنفي أو الإثبات، بقدر ما يهم أن يلتفت الإنسان إلى بشاعة الجرائم التي يلحقها بالطبيعة. هذه الجرائم التي لو استمر في ارتكابها ستجعل العيش على هذا الكوكب بعد قرون متعذرا للغاية. فالتلويث المستمر للبيئة عن طريق المركبات ذات المحرك التي تتناسل بشكل مهول، والمصانع التي لا تتوقف عن العمل، والرمي بالقاذورات في مياه المحيطات، وبث الغازات في الهواء، وقلع الأشجار التي تمثل رئتي هذا الكوكب: كل ذلك سيؤدي إلى تفاقم المشاكل البيئية والمناخية، إذا اعتبرنا أنها لم تتفاقم بعدُ. وما ارتفاع مستوى تراكم انبعاث الغازات المسببة للاحتباس الحراري عنا ببعيد.
إن الأمل كبير في أن تكون هذه الجائحة فرصةً لإعادة النظر في تدبير هذا الملف على مستوى العالم، لأن أحفادنا القادمين سوف يلعنوننا إذا لم نتصرف بالشكل الذي تقتضيه خطورة الوضع. يجب أن تكون هذه اللحظة فرصة لتصالح الإنسان مع ذاته، وتحمُّل الأمانة التي استئمن عليها باقتدار وجدارة، من أجل ضمان استمرار الحياة بشكل طبيعي للأجيال القادمة. فلسنوات طويلة مضت، لم تعد الخطابات التحذيرية في مختلف اللقاءات العالمية لحماية البيئة كافيةً، والإنذار بقرب الانهيار لم يعد يُجدي، والقول بأننا نسير بخطى حثيثة إلى الهاوية أصبح أمرا معلوما للجميع، حتى إنه لَتنعدم الفائدة في التنصيص عليه. إن التعامل الأناني والجشِع مع الطبيعة، واستنزاف مواردها بشكل غير رشيد، والإخلال بالتوازنات البيئية قد أصبح يمثل قنبلة على وشك الانفجار، ولن تستثني أحدا، مهما كان صالحا.
في كتابه “الأرض غير الصالحة للسكن – The Unhabitable Earth” يورد الكاتب ديفيد والاص ويلز جملة شديدة، وهو يصف جرائم الإنسان الحديث اتجاه بيئته، فيقول: “جاء أكثر من نصف انبعاثات الكربون في غضون العقود الثلاثة الماضية فقط، وجاءت الأغلبية الساحقة منذ الحرب العالمية الثانية. إنه ليس من قبيل المبالغة أن نقول: إن هذا الكوكب خرّ على ركبتيه في غضون جيل واحد، وأن مهمة إنقاذه تقع على عاتقنا الآن فقط […] الآن قبل فوات الأوان”.
إن هذا الكلام ليس مبالغة مجازية، أو محاولة لتنميق العبارة. إنه يصف حقيقة واقعية: إن كارثة بيئية توشك أن تحدُث، وسوف ندفع ثمنها جميعا.
والاحتباس الحراري ليس حدثا يحدث فقط ويمضي، بل حدث يستمر وله نتائج. فقد أكد المجلس الاستشاري العلمي للأكاديميات الأوروبية أن التداعيات السلبية لظاهرة الاحتباس الحراري على الصحة تظهر في مستويات مختلفة، حيث تشمل زيادة التعرض لدرجات الحرارة المرتفعة، وتلوث الهواء، وانتشار المواد المثيرة للحساسية، وضعف سلامة الأغذية وارتفاع مخاطر الإصابة بالكثير من الأمراض المعدية، وغير ذلك من النتائج السلبية. فقد يكون هذا الفيروس نفسه من نتائج هذه الكارثة البيئية، بل إننا لا نستطيع إلا أن نربطه بها، بشكل من الأشكال.
ووفقا لنفس المجلس، فقد تضاعف عدد العواصف منذ عام 1980، وأصبحت درجة واحدة فقط من الاحترار تزيد من تكرار الأعاصير من الفئة 4 و 5 بأكثر من 25 في المائة، على مستوى العالم. ويضيف تقرير المجلس أنه بحلول عام 2100، من المتوقع أن تتضاعف وتيرة الأعاصير الخطيرة من نوع إعصار كاترينا مرتين! وبين المجلس أن درجة واحدة فقط من الاحترار، تُخفِّض غلة محاصيل الحبوب بنحو 10 في المائة. وفي ظل الخمسة عشر عامًا الماضية، لاحظ عالم الرياضيات الرائد Irakli Loladze أن الأجواء الغنية بثاني أكسيد الكربون، وإن كانت تجعل النباتات تنمو بشكل كبير، إلا أنها تقلل من قيمتها الغذائية. كما وجدت إحدى الدراسات أنه منذ عام 1950، انخفض المحتوى الغذائي للنباتات الزراعية بنسبة تصل إلى 33 في المائة. وهذه النتائج السلبية إذا استمرت في الحدوث بشكل مطرد لوقت قصير سوف تؤدي إلى كوارث طبيعية وإنسانية لن تطاق.
وبالعودة إلى الكتاب المذكور آنفا، فقد بين الخبراء أن منع هذه السيناريوهات المروعة متوقف بشكل حاسم على ما سنقوم به في الأعوام العشر القادمة. ولكن المؤسف في الأمر أنه لا يبدو أننا نتوجه إلى القيام بأي شيء لمنع وقوع هذه الكوارث المتوقعة. بل إنه ليس من السهل القيام بإجراءات فعالة لمنع ذلك، إذ استحكمت العادات الاستهلاكية السلبية على نمط حياة الناس، إلى درجة أن أمريكياً واحدا عاديا يُصدر من الكربون مقدارا يكفي لإذابة 10000 طن من الجليد في القطب الجنوبي. وقد أثبتت صور نشرتها وكالة الفضاء ناسا في بداية شهر فبراير الماضي كيف أن أقطابا ثلجية قد ذابت بالكامل في القطب الجنوبي، بعد ارتفاع درجة الحرارة إلى مستويات قياسية؛ وصلت إلى 18.3 درجة مئوية. وهو مستوى قياسي لم يسبق أن تم تسجيله من قبل. ولا شك أن هذا سوف يؤدي إلى ارتفاع منسوب المياه في المحيطات، مما ينذر بكوارث وفياضانات خطيرة قادمة لا محالة، حسب الخبراء.
ومن الأدلة على أن البشرية لن تقوم بأي شيء لمنع هذه الكوارث، إصرار عدد من الدول الكبرى على إبقاء المصانع غير الضرورية تعمل بشكل عادي في أثناء هذه الجائحة، مع ما في ذلك من خطورة حالّة على صحة العمال وحياتهم وحياة أسرهم؛ حيث إنه قد تم إيثار التضحية بصحة الناس وأرواحهم في سبيل الحفاظ على صحة الاقتصاد وتعافيه. أي أن الإنسان رسميا قد صار في خدمة الاقتصاد، بدل أن يكون الاقتصاد في خدمة الإنسان. الجشع الرأسمالي أعمى أرباب الشركات واللوبيات الاقتصادية. ولعله من السذاجة أن نتوقع منهم أن يضحوا بأرباحهم الخيالية من أجل صحة عامل بسيط أو روحه، أو أن يُنقصوا من إنتاجيتهم الصناعية من أجل “النظرة الملائكية” للبيئة والمناخ والطبيعة.
لكن، هل تكون كورونا المصيبة النافعة، التي ينطبق عليها قولهم: رب ضارة نافعة؟ قد يكون من الفج أن نتحدث عن إيجابيات لفيروس كورونا، بحكم أنه قد حصد أرواح الكثيرين، وقد يرى فيه البعض عملا غير أخلاقي، لكني شخصيا أجد الأمر عاديا، فاحترام الموتى الذين قضوا في هذه الجائحة، واحترام مشاعر ذويهم الذين تألموا من الفقد، لا يمنع أبدا من الحديث عن الدروس المستفادة من هذه الجائحة، ولا يمنع كذلك من التذكير بالمنافع البيئية التي نتجت عن فرض الحجر الصحي على عدد كبير من سكان هذا الكوكب. فقد انخفضت مستويات التلوث، لأول مرة، بسرعة ملحوظة، نتيجة مكوث ثلاثة ملايير إنسان في منازلهم. كما أنه حسب جريدة الفاينانشل تايم ليوم 14 أبريل – تاريخ كتابتي لهذه الأسطر – قد سجل رقم قياسي في انخفاض المستويات العالمية لثاني أكسيد النيتروجين، وهو ملوث مرتبط بالسيارات، وعرف الهواء في كل المدن الكبرى من نيودلهي إلى بكين ولوس أنجلوس نقاءً وجودةً أنظف من أي وقت مضى في الذاكرة الحديثة.
ومهما كان الأمر، فتظل جوانب كثيرة من هذه الجائحة يلفها الكثير من الغموض. سننتظر أن تكشف الأيام المقبلة عن معطيات وتفاصيل أكبر قد تُعيننا في تسديد فهمنا لما يجري. والمؤكد أن هذا الفيروس قد دفعنا للتفكير مليا في أنظمتنا الاقتصادية ورؤانا للحياة. دفعنا أن نجرب جميعا معنى أن تعيش وأنت ترقب عدوا غير مرئي يمكن أن يهاجمك في أية لحظة، وأن تخرج من المنزل وأنت تخاف أن تعود إلى أولادك وأنت تحمل إليهم العدوى. هذا الفيروس علمنا قيمة الأمان والاطمئنان، وقيمة أن نعانق أحبابنا من غير خوف علينا وعليهم، وقيمة أن تسافر إلى أي مكان تريد، والأهم من كل ما سبق، قيمة أنك تتنفس من غير مشكلات تذكر.